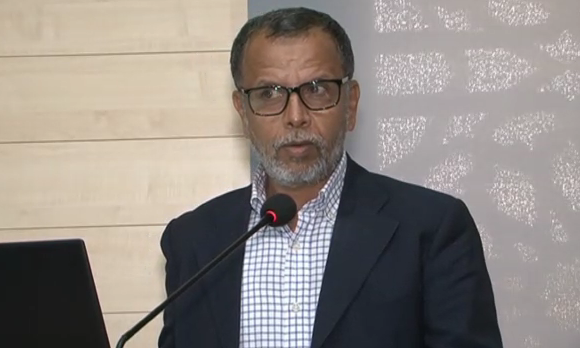في ذلك المساء، عند خالتي السعدية، في بيت " عزيزي علي" البيت المتواضع لكن المشعّ بالدفء الذي لا يُضاهى والنور الداخلي الذي لا ينطفئ، كان خالي عبد الجبار، ذلك الرجل ذو الصوت الهادئ والكلمات الحادة، ينبش في حقيبته الجلدية السوداء الصغيرة، تلك الحقيبة التي لا تفارقه، وكأنها تحمل كنوزًا أعظم مما يبدو للعين.
بحركة بطيئة وأقرب ما تكون إلى الطقوس، أخرج من الحقيبة مجلة خضراء الغلاف، بسيطة ومتقشفة، وكأنها دعوة للتأمل في عوالم جدية وثقيلة.
وضعها أمامي، ثم، بنبرة يملؤها خليط من الحنان والجدية، قال:
"ولد أختي، هذه مجلة اسمها "المجلة الصحية". أسّسها طبيب مغربي، الدكتور عبد الكريم عمري، الذي درس الطب في سوريا.
كان رجلاً صاحب رؤية متقدمة.
اكتب لي مقالًا تقديميًا عن هذه المجلة، أريد نشره في العَلَم. "
للتاريخ الدكتور عبد الكريم عمري تركنا للدار الاخرى عام 2023.
في تلك الآونة من عام 1981، كنت آنذاك في سنتي الثالثة بكلية الطب، عقلي منشغل بالتشريح والكيمياء الحيوية وعلم العلامات الطبية sémiologie لكنني لم أكتب أبدًا أي مقال صحفي، وبالأخص باللغة العربية.
رغم ذلك، كان ذلك المساء بداية رحلة أدبية وصحفية سترافقني مدى الحياة.
في الأسابيع التي تلت، بدأت أعيش حالة من الغليان الفكري.
تحت إشراف عبد الجبار، كتبت مقالات عن الصحة، ثم عن السينما، شغفي الآخر.
كان عبد الجبار، الصحفي المحنك، يؤمن بالجسور التي تربط بين العلم والفن، بين العقل والخيال.
وفي يوم آخر، بأسلوبه المباشر والحاسم، قال لي:
"اذهب إلى مَن يدفع مستحقات المتعاونين الخارجيين مع العَلَم. "
صعدت السلالم في مبنى الجريدة، وقلبي يخفق بالحماس، أحلم بأول أجر في حياتي، بمكافأة تليق بالسهر والتعب.
لكن الواقع كان صادمًا.
الرجل المسؤول عن الدفع، رجل دقيق المظهر وحاد التصرفات، أخرج شريط قياس طويلًا "الميترو" وأكوامًا من أعداد الجريدة التي نشرت بها مقالاتي.
بدأ يقيس بالسنتيمتر كل عمود كتبتُه، كل كلمة خرجت من قلمي. ثم، بعد عمليات حسابية طويلة على آلة حاسبة قديمة، فتح درجًا يصدر صوتًا مريبًا، وأخرج صندوقًا مليئًا بالأوراق النقدية المهترئة وبعض قطع النقود المعدنية.
المبلغ الذي أعطاني إياه كان صفعة لكل أوهامي.
بضعة أوراق نقدية وكثير من القطع المعدنية.
نزلت السلالم بخطوات ثقيلة، وقلبي يكاد ينفجر من الخيبة.
في الخارج، قررت البحث عن ملاذ مؤقت. توجهت إلى سينما "رويال"، حيث أذبت خيبتي في ظلمة الصالة وبين الصور المتحركة.
الألوان على الشاشة كانت مثل بلسم لجرحي الجديد.
عند خروجي من السينما، اتجهت إلى حانة بائسة خلف مبنى الجريدة. طلبت ما سمحت به نقودي المتبقية من زجاجات البيرة.
كانت كل رشفة تمثل انتقامًا هادئًا ضد ظلم العالم.
بلا أي درهم في جيبي، أخذت طريق المشي، أعبر شوارع الرباط تحت أضواء المصابيح الخافتة، ورأسي مليء بأحلام مكسورة.
وجهتي كانت مدينة سلا، حيث بيت الأسرة ما زال يوفر لي المأوى والطعام و ثمن تذاكر الحافلة – الخط 6 والخط 23 – التي تأخذني يوميًا إلى كلية الطب في حي العرفان.
في تلك الليلة، رغم الإهانة والتعب، ولدت داخلي شعلة.
شعلة أشعلها عبد الجبار، أستاذي ومرشدي، الذي علّمني أن الكتابة، وإن كانت بلا مقابل يُذكر، هي سلاح.
سلاح ضد النسيان، ضد الظلم، وقبل كل شيء، ضد الصمت.
نم بسلام يا أستاذ عبد الجبار السحيمي.
كثيرون ممن ما زالوا على قيد الحياة يدينون لك بشهرتهم، بمكانتهم الاجتماعية، بل وحتى بزواجهم.