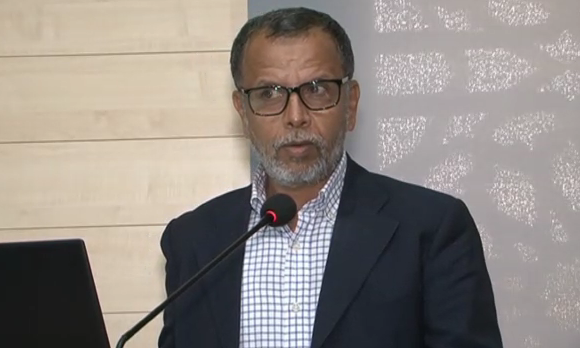في الزمن الذي راهنا فيه على الديمقراطية أن تنضج ويرتقي وعي الإنسان، فسدت الخلطة واغترب الذوق، فيها تاهت مكوناتها إلى أن فقدت السياسة نبلها فاحتد في دائرتها العصيان.
أسئلة ثقيلة تفرض منا التأمل والتحليل من موقف مسؤول.
علمونا في المدارس على أن الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، منهج عادل في تدبير السلط وأسلوب راق لإدارة شؤون الشعوب، كان المأمول أن تسهم هذه القناعة في رفع وعي الإنسان السياسي والاجتماعي، وأن ترسّخ قيم العدالة والمساواة وكرامة البشر، لكن يبدو أن الزمن أظهر عكس ذلك صار الواقع أمرا، إذ لم تحقق دائمًا ذلك الطموح المنتظر، حيث واجه مسارها العديد من التحديات، اغتر المسؤول، فتمرد على كل القيم، بعد أن انسحبت السياسة عن فن الممكن، صار العصيان عنوانا، نفرت الشعوب تعبيرا عن خيبة الأمل.
فأي عقبات واجهت عملية التنفيذ؟
في أغلب المجتمعات خاب الظن وتحول هذا الانحراف إلى كابوس حيث صار الجهل ألوانا ارتقى ميادين كثيرة حتى تهشمت وظيفة السياسي. حصل المسخ لمفهوم، طارده الكل بحثا عن الحقيقة، لكن الخروج عن المسار كان أقوى انتهي بفقدان الديمقراطية روحها فاختزلت في موسم وصندوق انتخابي، تشوهت قيمها بشكل أعمق، احتكر الإشراك في صنع القرار لان هذا الادراك يتطلب شعوبًا لها وعيا جمعيا.
تحولت السلطة هدفا للقادة، وحزاب الخردة نحو محراب الديمقراطية فصدروا هذا الهجين إلى الضفاف الأخرى كوصفة جاهزة فاقدة للبوصلة والجوهر.
لم يساهم الوعي المعكوس إلا في تحويل المنظار أداة لانتشار الفساد والمحسوبية، تحولت معه الديمقراطية إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية على حساب آمال الشعب وتطلعاته، لتتقوض العملية الديمقراطية في هذا العالم المترابط، وتصبح الديمقراطيات الناشئة معرضة لضغوط وتدخلات من القوى الأجنبية التي تسعى لتحقيق مصالحها، غدت هذه التدخلات إلى غرس أنظمة استبدادية، كانت سببا في زرع الفوضى بدعم من إعلام ماجور.
خابت أمل الشعوب في ديمقراطية لم تتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث اتسعت الفجوة دون رحمة وبشكل مقزز بين الأغنياء والفقراء، كان هذا الإخفاق سببا لفئات واسعة من المجتمع في حالات التمرد وفقدان الثقة في هذه الوصفة المسعورة كنظام فقد المصداقية وغير قادر على تحسين حياتهم.
اقترنت الديمقراطية كوسيلة بيد النخب الاقتصادية والسياسية، لتهميش الفئات الضعيفة من المجتمع، هذا التفاوت في القوة والتمثيل السياسي أدى إلى حالة من الإحباط والعصيان، أصبح من المستحيل لهذه الوصفة أن تبني عافيتها في بيئة تسودها النزاعات الطائفية أو القبلية أو العرقية، هذه التحديات استحال معها بناء أي توافق مجتمعي حول رؤية مشتركة، مما أضعف قدرة النظام الديمقراطي على العمل بفعالية.
لم تعد مؤسسة الإعلام هي الأخرى ذلك الفاعل الأساسي في تشكيل الوعي العام في عصر سيطرة الإنترنت والتكنولوجيا الخلاقة، فظهر إعلام بديل زاغت فيه وسائل التواصل الاجتماعي عن وظيفة نشر الوعي المعرفي، ليسود عوضه التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة ارتبطت محتوياته بكتل من التفاهة، حرفت الرأي العام ضد مصالحه الحقيقية، مما أثر على نزاهة العملية الديمقراطية.
اذ لم تساهم هذه العوامل جميعها إلا في تراجع الثقة بين الشعوب والأنظمة السياسية لتترهل وتضعف المؤسسات السياسية الحاملة للوعي الشقي، بدلًا من تقويتها فتكرست النزاعات والتمردات، سواء كانت سلمية صامتة أو عنيفة وتصاعدت الحركات الشعوبية لتستغل ذلك الإحباط الجماهيري.
من هذا المنطلق لا يمكن التغلب على هذه العقبات بضربة مقص، فتعزيز التعليم والتثقيف السياسي ونشر الوعي والقضاء على الفساد بشكل حازم ومستمر، إذ لن يتأتى الوعي القومي الا بضمان أولا قضاء مستقل ومؤسسات رقابية تعزز الثقة في بناء سياسات اقتصادية وطنية تسعى إلى عدالة اجتماعية تحقق التوافق بين مختلف فئات المجتمعات، وتقلل الفجوة بين الطبقات لتحفز على ثقافة الحوار بين المواطنين، وحتى تلعب الصحافة دورها الرقابي تحتاج الى دعم قوي يعيد الاعتبار لضوابط النزاهة والأخلاق المهنية.
لا شك أن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل هي ثقافة وقيم تحتاج إلى بيئة مناسبة لكي تثمر، صحيح انها قد تواجه عقبات في التنفيذ، إلا أن هذا لا تعني فشلها غو نهايتها، بل الدعوة تستدعي التقييم ومراجعة وتقويم التجارب، والعمل على معالجة التحديات سياسية، لأن نبل السياسة مقترن بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة المجتمعية.
السؤال المطروح هل العناصر المؤثرة في العملية الديمقراطية، كل من المثقف، رجل السياسة، والمجتمع المدني تقوم بالدور المنوط بها؟
لأن تحليل طبيعة كل دور وعلاقته بتحقيق التغيير رهين بالتأثير في الدولة والمجتمع فإذا كان المثقف ذلك الحامل للوعي النقدي ويساهم في تشكيل الرأي العام من خلال إنتاج الأفكار وتحليل الواقع فإن دوره لا يتوقف عند كونه مراقبًا، وإنما يتجاوز ذلك إلى نقد السلطة لكونه المسؤول الأول عن تعزيز الوعي وتنوير المجتمع محورياً من خلال صياغة الأسئلة الجوهرية التي تُحفِّز النقاش والتأمل.
اذا كان النظر إلى المثقف على أنه ضمير المجتمع، يفترض فيه الاستقلالية، والجرأة في نقد السلطة السياسية والاجتماعية حين خروجها عن المعايير الأخلاقية، أو تقصير في أداء واجبها في إنتاج المعرفة، فمهمة المثقف محددة في توجيه المجتمع نحو الفهم العميق لقضاياه، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، أو سياسية، كما أن وظيفته تتمثل في التأثير الفكري وليس في اتخاذ القرارات لأنه لا يمتلك سلطة تنفيذية مباشرة.
أما رجل السياسة فدوره مختلف تمامًا، لأنه معني بالممارسة المباشرة للسلطة وإدارة الدولة لدلك تتمحور مهمته في صناعة القرارات المؤثرة مباشرة في حياة الناس، سواء كانت ذات طابع تشريعي، تنفيذي، أو دبلوماسي، فغالبًا ما يضطر السياسي إلى الموازنة بين أيديولوجيته ومتطلبات الواقع العملي، لأن تمثيل الشعب يفترض عليه التعبير عن إرادته والعمل على تحقيق مصالحه.
ان ما يميز رجل السياسة هو أن عمله ضمن إطار الدولة، وهدفه تحقيق استقرارها، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات، خلاف المثقف الدي يرفض تقديم التنازلات مادامت تناقض القيم والمبادئ الإنسانية.
ويبقى العنصر الثالث في المجتمع المدني ذلك الوسيطً بين الفرد والدولة، ويشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، وغيرها فدوره يتجاوز عملية التحريض إلى أدوار أعمق كالرقابة على السلطة حيث مراقبة أداء الحكومة، وتسليط الضوء على الاختلالات والانتهاكات لان مهمته محددة في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وينظم الحملات بهدف إصلاح السياسات أو تغييرها، لبناء الوعي المجتمعي والمساهمة في تعزيز ثقافة المشاركة والحوار بين الأفراد، لان الدور الإيجابي متمثل في إثارة الوعي وتحفيز المجتمع للمطالبة بحقوقه و رفض الظلم، وليس بالضرورة بالمعنى السلبي.
من هنا تصبح العملية الديمقراطية نتاج العلاقة التكاملية بين مثقف يُنتج الأفكار ويحرك الوعي، ورجل سياسة يطبق القرارات ويترجم الأفكار إلى أفعال، ليلجا المجتمع المدني الى ممارسة الضغط والرقابة لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
فالاختلاف في الأدوار لا يعني التنافر، بل التكامل، كل طرف يساهم بطريقته في بناء دولة متوازنة، حيث المثقف يجيد طرح الأسئلة، والسياسي يُجيب عمليا، والمجتمع المدني يضمن المساءلة.
فمتى تستعيد الديمقراطية عافيتها في اوطاننا؟
وأية وصفة لعودة المسار الديموقراطي إلى طبيعته؟