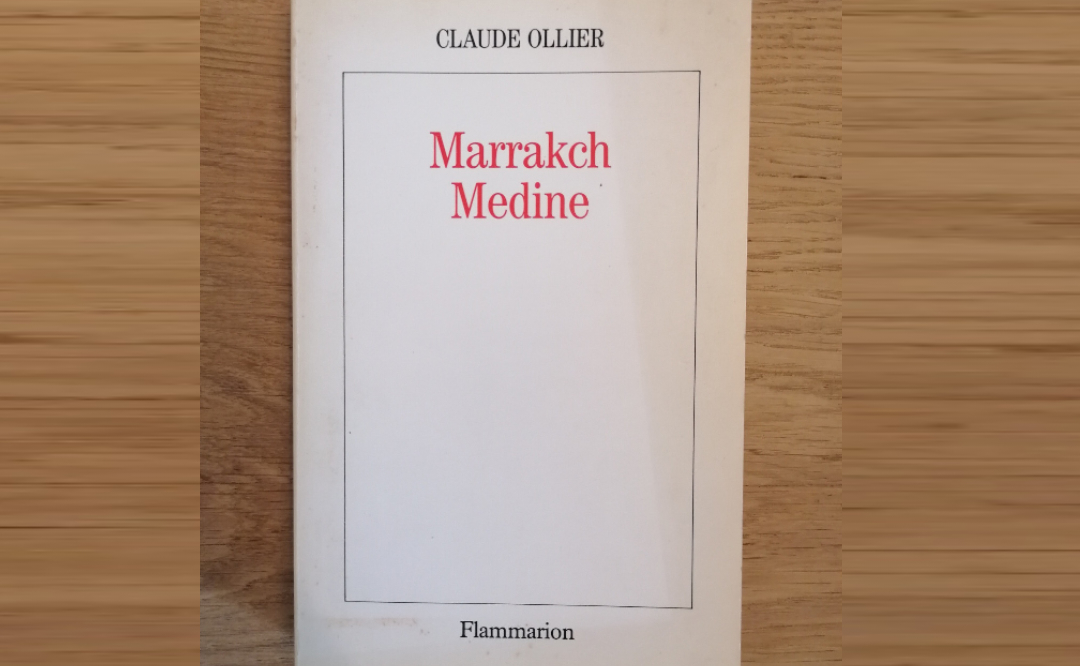ثمة لحظات في تاريخ المجتمعات لا تحتاج إلى تقارير رسمية أو أرقامٍ صادمة كي تدرك حجم التدهور. يكفي أن تنصت قليلًا إلى لغة الناس، إلى نوعية النقاشات، إلى السقف الأخلاقي الذي يحكم الخلاف، حتى تفهم أننا لا نتقدم كما نزعم، بل ننحدر بهدوءٍ نحو القاع.
ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة عابرة أو سوء تدبير ظرفي، بل أقرب إلى تفسّخ عام يطال المعاني قبل المؤسسات. كل شيء يبدو كما لو أنه فقد صلابته: السياسة، الثقافة، الإعلام، وحتى الكلمات الكبيرة التي كنا نحتمي بها ذات زمن. هزلت، بكل المقاييس.
في المؤسسة التشريعية، حيث يفترض أن يرتفع مستوى النقاش، نرى العكس تمامًا: شعبوية فجة، ملاسنات، واستعراضات صوتية لا علاقة لها بالتشريع ولا بالرقابة. وفي الأحزاب، التي يُفترض أن تؤطر المجتمع وتنتج الأفكار، حلّ التدبير اليومي الضيق محل المشروع الفكري، وغلب هاجس البقاء على هاجس المعنى. أما الصحافة، «مهنة المتاعب» كما كانت توصف، فقد أصابها ما أصاب غيرها: ارتباك في الأدوار، خلط بين الخبر والدعاية، وبين النقد والابتزاز، وبين الحرية والفوضى.
النتيجة أن المجال العام صار مسرحًا مفتوحًا للمدّعين. محترفو التشهير، تجار الإثارة، صناع الضجيج، ومروجو التفاهة باتوا هم الأعلى صوتًا. لا يملكون معرفة ولا خبرة ولا تراكمًا، لكنهم يتقنون فنّ الظهور. يتحدثون باسم الجميع، ويفسّرون الوطنية على مقاسهم، ويوزّعون صكوك الغفران، ويقيمون محاكم لتفتيش النوايا والأفكار. من يوافقهم يُلمَّع، ومن يختلف يُخوَّن.
إنها سلطة رمزية بلا شرعية، لكنها فعّالة. لأنها تقوم على أبسط الغرائز: الخوف، الغضب، والتحريض.
على منصات مثل فيسبوك وبقية شبكات التواصل، يصبح الكلام مجانيًا بالكامل: لا كلفة للاتهام، ولا مسؤولية عن التشهير، ولا ثمن للكذب. في هذا الفضاء السائل تزدهر «تجارة الوطنية». يزايد البعض على الدولة نفسها في تمجيدها، ويتحول المديح إلى مهنة، والولاء إلى عرض يومي، وكأن الوطنية صراخٌ دائم لا ممارسة هادئة. يتوهم هؤلاء أن المبالغة في التطبيل ستكافأ يومًا ما، فينافسون المؤسسات في الدفاع عنها أكثر مما تفعل هي.
لكن هذا النوع من الوطنية ليس إلا قناعًا. إنه شكل من أشكال الشعبوية الانفعالية التي تخلط بين حب الوطن واحتكار تفسيره. بين الانتماء والوصاية. بين النقد والخيانة.
الأخطر أن هذه الضوضاء لا تكتفي بتشويه النقاش، بل تقتل الكفاءة نفسها. فالمثقف الجاد، والصحافي المهني، والفاعل الحزبي المسؤول، يحتاجون إلى وقتٍ للتفكير، وإلى لغة دقيقة، وإلى حجج. بينما يكفي للخطاب الشعبوي جملة حادة وصورة مفبركة وإشاعة سريعة. وهكذا يخسر العقل أمام الانفعال، والتراكم أمام اللحظة، والمعنى أمام الإثارة.
بهذه الطريقة نهدم بأيدينا ما بُني خلال عقود: تقاليد مهنية، أخلاقيات عمل، ذاكرة نضال، وتضحيات أجيال كاملة. النخب، بدل أن تقاوم هذا الانحدار، انكفأت على ذاتها. خائفة على مواقعها، متوجسة من المستقبل، منفصلة عن المجتمع. تركت الساحة فارغة، فملأها الأدعياء.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما جدوى الثقافة إذن؟ ما جدوى الفكر؟ ما جدوى الأحزاب والنقابات والصحافة إذا كان المجال العمومي محكومًا بمنطق السوق، حيث تختلط البضاعة الأصلية بالمغشوشة، ولا رقيب ولا حسيب؟
في إحدى الندوات، سمعت مفكرًا مغربيًا يقول إن الدولة هي أعظم اختراع في تاريخ البشرية. لم يكن يقصد الدولة كجهاز إداري فقط، بل دولة الحق والقانون والمؤسسات. الدولة التي تحمي المجال العام من الفوضى، وتضمن تكافؤ الفرص، وتصون النقاش من الانحطاط.
وحين تغيب هذه الدولة، أو تتردد في أداء هذا الدور، يملأ الفراغ خطاب الصوت الواحد. خطاب يريد الجميع نسخًا متشابهة، ولغة واحدة، وتأويلًا واحدًا. غير أن التجارب كلها تثبت أن هذا الخيار لا يحمي الدولة، بل يضعفها. لأن المجتمعات الحية تتغذى من التعدد والاختلاف، لا من الجوقة الموحدة.
فالانتماء ليس صفيرًا ولا زعيقًا. الوطنية ليست مباراة في المزايدة ولا حلبة للملاكمة اللفظية. إنها قناعة هادئة، وتربية على القيم، وممارسة يومية للنزاهة والمسؤولية. من يحب وطنه لا يحتاج إلى الصراخ باسمه كل ساعة، ولا إلى تخوين الآخرين لإثبات إخلاصه.
ما نحتاجه اليوم ليس مزيدًا من الضجيج، بل قدرًا من الرصانة. ليس المزيد من «المؤثرين»، بل المزيد من المهنيين. ليس خطابات حماسية، بل مؤسسات قوية وقواعد واضحة ومساءلة حقيقية. باختصار: نحتاج إلى إعادة الاعتبار للعقل.
لأن المجتمعات لا تنهار فجأة. إنها تتآكل ببطء، حين تصبح التفاهة معيارًا، والادعاء فضيلة، والصمت عن الرداءة نوعًا من الواقعية.
عندها فقط ندرك، متأخرين، أننا لم نكن نسير إلى الأمام كما تخيلنا… بل كنا ندور في حلقة مفرغة، نستهلك الكلمات الكبيرة فيما المعاني تصاب بشروخ والقيم تنهار وتتصدع جدرانها.