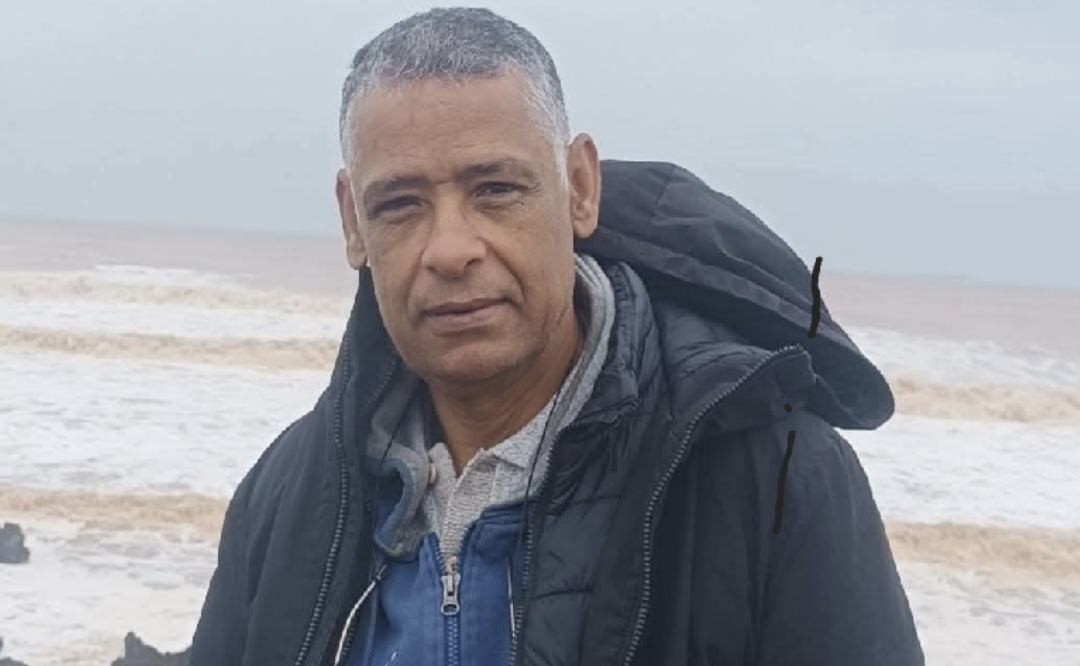وجاء معه شيء آخر لا يُرى بسهولة: عاد الزمن القديم يمشي على أطراف أصابعه داخل الذاكرة.
كنا ونحن صغاراً نعيش المطر كما لو كان خصماً مؤقتاً لأحلامنا.
لم يكن المطر عندنا مجرد فصلٍ جميل، بل كان امتحاناً لطريقٍ ضيّق، غير معبَّد، مليء بالمنحدرات التي تُخيف العجلات وتُربك الحافلات وتُرغمنا على الانتظار.
كنا نحب البادية حدَّ الشغف، لكننا كنا أيضاً نحب الوصول إليها بسرعة… لذلك كنا نرفع أكفّنا إلى السماء، لا ندعو بالغيث كما يفعل الناس عادة، بل ندعو أن يتوقف.
يا للمفارقة… نحن الأطفال كنّا نريد أن يهدأ المطر، كي تبدأ المغامرة.
كان الطريق إلى الضيعة يبدو لنا أطول مما هو عليه، لا لأن المسافة كبيرة، بل لأن الشوق كان أكبر.
وكان وادي زيلي بالنسبة لأحلامنا الصغيرة أشبه بالبحر الأبيض المتوسط: واسعاً في الخيال، عظيماً في العين، مهيباً في القلب.
مياهه كانت تعني “وصلنا”، وتعني أيضاً “انتبهوا”… لأن الوادي حين يغضب لا يكتفي بالماء، بل يبتلع الطريق ويحبس الخطوة ويغيّر المواعيد.
وفوق ذلك… كانت هناك تلك البركة المائية في الجانب العلوي من الضيعة:
تمتلئ بالماء والعشب، وتصير فجأة ملعباً طبيعياً مفتوحاً، لا حارس عليه ولا أسوار، فقط ضحكاتنا، وملابسنا المبتلة، ورائحة الأرض حين تصحو.
كان المطر يومها يعطل ذهابنا… كما يعطل إيابنا.
وحدث ذات صيف أن باغتنا مطر غزير في نهاية العطلة، فأخر عودتنا.
تبدّلت الدعوات: لم نعد ندعو للذهاب هذه المرة، بل للرجوع… إلى سلا، إلى المدرسة، إلى الواجبات التي تنتظرنا ببرودة جافة لا تشبه دفء الطين.
كنا محاصرين بين رغبتين:
أن نكمل الحلم… وأن نعود إلى الواقع.
وفي كل مرة، كان المطر هو من يقرر.
ثم مرت السنوات.
كبرنا، وتغيرت الطرق، وصار الإسفلت يغطي ما كان بالأمس مجرد ترابٍ وعنَاد.
ظننا أن الزمن قطع علاقته بتلك التفاصيل الصغيرة، وأن الذاكرة صارت مثل صورة قديمة لا تتحرك.
لكن اليوم… بدأت الأيام الجميلة تعود.
عادت الأمطار كما كانت، وصار الناس يقولون إن الطريق – رغم أنها معبدة – أصبحت صعبة المرور.
كأن الأرض نفسها لا تريد أن تفقد لغتها الأولى، كأنها تقول لنا:
لا شيء يتغير تماماً… فقط نحن الذين ننسى.
اليوم، حين يهطل المطر، لا أشعر أنه يعطل شيئاً.
بل أشعر أنه يُصلح شيئاً في الداخل.
يرمم جزءاً قديماً من القلب، ويعيد ترتيب الذكريات كما يعيد الغيث ترتيب التراب.
نسمع صوت قطراته في النوافذ فنبتسم دون سبب واضح، ثم نفهم بعد لحظات:
هذا ليس مطراً فقط…
هذه طفولة عادت تطرق الباب، وتسألنا إن كنا ما زلنا نتذكر طريق الوادي، ورائحة العشب، ولحظة الانطلاق.
والأجمل في الأمر أننا اليوم لا نرفع أكفنا ليكف المطر…
بل نرفعها ليطول قليلاً.
لأننا تعلمنا متأخرين أن المطر ليس عائقاً…
إنه “رسالة” تقول: ما زالت السماء قادرة على العطاء، وما زالت الأرض تبتسم حين تُسقى.
كانت الأرض معطاءً، ولم نكن نحتاج للسقي ولا للسقي بالقطرات…
ثم شحت السماء سنوات كثيرة، وتعبت الحقول، وانحنت الأشجار كأنها تعتذر عن قلة الثمر.
وها هو اليوم المطر يعود، لا ليُغرق الطرق فقط، بل ليُعيد للناس شيئاً من الطمأنينة.
كأن الغيم حين عاد، عاد ومعه معنى ضائع:
أن الحياة يمكن أن تبدأ من جديد… بقطرة.
أخيراً جاء المطر…
وجاء معه الحلم الجميل.
وعادت الطفولة تجر خلفها أحلاماً صغيرة كانت تنتظر فقط أن تبتلّ الأرض… لتصدق أنها ما زالت ممكنة.