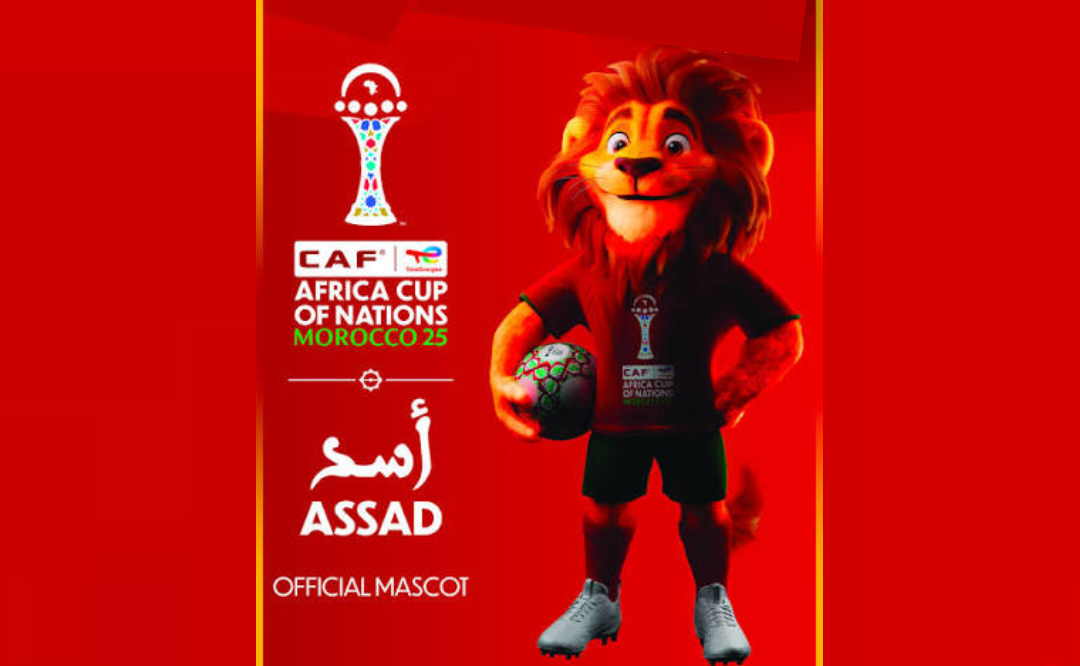لا جديد تحت الشمس. مشاريع التعديلات التي جاءت بها الحكومة بخصوص “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، لم تحمل مفاجأة إيجابية واحدة( إذا استثنينا رفع التمثيلية النسائية). جاءت، كعادتها، بدون استشارة أهل المهنة، وكرّست منطق الانفراد، وحافظت على أعطاب تجربة وُلدت مشوهة، بل ذهبت أبعد من ذلك: منحت شرعية قانونية لتغوّل الناشرين الكبار، ورسّخت منطق الهيمنة والرقابة، تحت لافتة “التنظيم الذاتي”
كيف ذلك؟
منذ البداية، وُلد “المجلس الوطني للصحافة” بإعاقة جوهرية حوّلته إلى هيئة مهنية لا يسود فيها المهنيون. وهو ما كرّسته التعديلات التي تقدّمت بها الحكومة اليوم، بل حافظت عليه.
نحن أمام نموذج فريد من نوعه في العالم، بل يمكن اعتباره من أسوأ النماذج الدولية في هذا المجال، حيث تبدو قوانين الصحافة التي كانت سائدة خلال سنوات الرصاص أكثر رحمة منه.
تجارب العالم الديمقراطي تقول شيئًا واحدًا: التنظيم الذاتي لا يُفرض من فوق. إنه آلية داخلية للمهنة، تُبنى على التمثيل، والاستقلالية، والمسؤولية. أما في حالتنا، فالحكومة تقرّر، وتعدّل، دون استشارة ولا إخبار من يعنيهم الأمر، وتقترح القوانين، وتراقب المداولات، وتموّل المجلس، ثم تدّعي بعد كل ذلك أنه “ذاتي”! أي ذات هذه التي تُدار بوصاية وتشريع حكومي.
والمفارقة أن مشروع التعديلات ينص، في “المادة 3”، على أن من مهام المجلس: “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”. لكن لا توجد على سطح الأرض تجربة في “التنظيم الذاتي” تقترحها الحكومات وتنفذها بمعزل عن المعنيين بها.
التجارب الدولية وتوصيات المنظمات العالمية، مثل اليونسكو و”المادة 19”، واضحة في هذا الصدد: التنظيم الذاتي للصحفيين هو شأن يخص الصحفيين وحدهم، وليس الحكومات.
الأخطر من ذلك أن مشروع التعديلات يسعى إلى فرض منطق الاحتكار في قطاع الصحافة. فبخلاف المعمول به عالميًا، حيث لا يُعتمد معيار رأس المال وعدد المستخدمين كمرتكز وحيد للتمثيلية، جاءت المسودة لتكرّس ذلك.
ففي “الفرع الثالث” المتعلق بانتداب ممثلي الناشرين، ألغت المسودة آلية الانتخاب، واعتمدت “الانتداب”، بحيث تُوزّع حصص التمثيلية بحسب حجم المقاولة ورقم معاملاتها. كلما ارتفع عدد الصحفيين والمستخدمين، ارتفعت حصة الناشر، وتضاعفت كلما ارتفع رقم المعاملات السنوي.
وتنص المادة 49 على أن المنظمة المهنية التي تحوز أكبر عدد من الحصص التمثيلية “تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس”، ما يعني إقصاء المنظمات المهنية الصغرى وانفراد كبار الرأسماليين بالتمثيلية.
بهذا المنطق، يشجع المشروع الاحتكار والتكتلات، وينتصر لتغوّل “الناشرين الكبار”، على حساب مبادئ التعدد والتنوع والمساواة.
بينما تعمل التجارب الدولية على تنظيم الناشرين وفق الأصناف، وتحافظ على تمثيلية متوازنة تضمن الحقوق والواجبات للجميع، صغارًا وكبارًا، بما يتيح المشاركة والتعددية، فإن المشروع الجديد يكرّس منطق السوق والهيمنة ويقصي المقاولات الناشئة والتعبيرات الصحفية الجديدة.
من الواضح أن المقتضيات التي جاء بها المشروع بخصوص طريقة انتخاب ممثلي الصحفيين وانتداب ممثلي الناشرين، تم إعدادها على مقاس هيئات معينة. ولن يكون مفاجئًا أن تؤول التمثيلية كلها لجهة واحدة وتوجّه وحيد.
جاء المشروع أيضًا لتكريس طابع الرقابة والعقاب على الصحفيين، بدل الدفاع عن حرية الصحافة والنشر. فقد حافظ على النهج العقابي والرقابي ذاته، في وقت كان الأمل فيه أن يتحوّل المجلس إلى سلطة معنوية وأخلاقية تدافع عن حقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، وتوسيع هامش حرية التعبير والنشر، مع حذف المقتضيات التأديبية.
وبالإضافة إلى ما يتضمّنه القانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، و”ميثاق الأخلاقيات” الخاص بالمجلس، جاء المشروع ليضيف طبقة رابعة من العقوبات التأديبية، يُشرف عليها رئيس المجلس والجمعية العامة، عبر ما سمّاه “القضايا التأديبية”.
وبهذا أصبح الصحافيون في مواجهة أربع طبقات وجهات تتولى التأديب والعقاب والرقابة…كيف سيفلتون بجلدهم؟ بل كيف سيمارسون عملهم بكل حرية؟
المجلس فاقد لاستقلاليته منذ التأسيس، إذ أنشأته الحكومة بقانون، ثم انفردت بتعديله، في أقصى أشكال الوصاية. لا علاقة له بالتنظيم الذاتي، وتُشارك فيه هيئات من خارج المهنة، وإن تم تقليص عددها في التعديلات. كما يُراقب عمله مندوب للحكومة، حتى لو بصفة استشارية، ويعتمد ماليًا على ميزانية الدولة ومساهمات كبار الناشرين.
إنه شكل من أشكال “الحجر والحماية” المفروضة على الصحفيين.