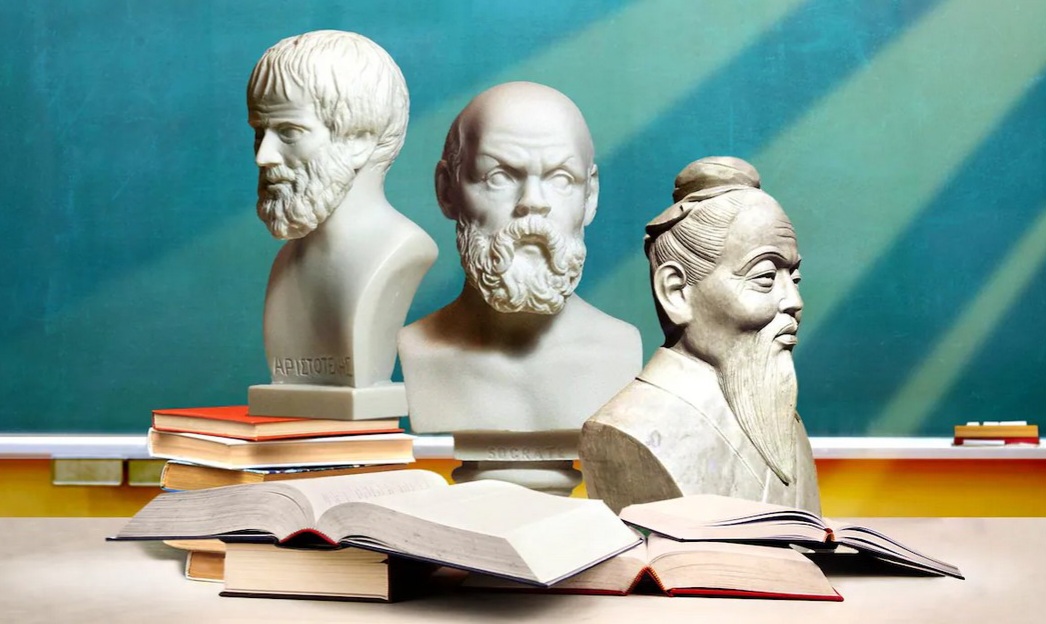أم العلوم التي ما فتئت "تتدخّل في كل شيء"
يحتفل العالم كل ثالث خميس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بـ"اليوم العالمي للفلسفة" الذي أعلنته منظمة "يونسكو" في 2005. لمناسبة هذا اليوم، يكتب عبد السلام بنعبد العالي عن العلاقة بين "أم العلوم" والأدب.قيل إن الفلسفة هي أم العلوم. بما هي أم، فهي ما فتئت ترعى أبناءها وتتدخل في شؤونهم. تدخلها في الأدب، بل حتى في غيره من الدراسات والفنون، أمر معهود. فلطالما أبدت الفلسفة فضولا و"تدخلا في ما لا يبدو أنه يعنيها"، ولطالما ادعت، خلال تاريخها، أن مهمتها الأساس هي التأسيس، مهمتها إقامة الأسس، أو لنقل، على الأقل، إنها كانت تحس في نفسها قدرة على التأسيس.
في هذا المعنى، بررت الفلسفة لنفسها خلال حقبة ليست بالقصيرة تدخلها في العلوم، بررت فضولها العلمي. وقد تبين في ما بعد أن العلوم ليست في حاجة إلى مثل هذا التأسيس، وأن التدخل الممكن للفلسفة في مجال العلوم، إن كان لا بد منه، لا يمكن أن يكون إلا مغايرا.
توضيحا للمسألة، لنكتف هنا بالإشارة إلى انتقادات غاستون باشلار ومساهماته في هذا المجال.
الأمر نفسه ينطبق على علاقة الفلسفة بالأدب. إن ربط الفلسفة بالأدب لا ينبغي أن يفهم هنا تأسيسا فلسفيا للفعالية النقدية، كأن تدعي الفلسفة أن كل نقد يقوم على جهاز مفاهيمي، ومهمتها هي، أن تعمل على إبراز الأسس الفلسفية التي يقوم عليها ذلك النقد.
وظيفة الفلسفة
إن لم يكن الأمر على هذا النحو، وإن لم تكن علاقة الفلسفة بالأدب علاقة تأسيس، فما المقصود بربط الأدب بالفلسفة، من طريق هذا الواو الذي يحب أحد الزملاء التونسيين أن يسميه "واو القضية"؟
محاولة للإجابة عن هذا السؤال، ربما اقتضى الأمر توضيحا لـ"وظيفة" الفلسفة. لا نقصد بالفلسفة هنا فلسفة بعينها، ولا مجموع الفلسفات، وإنما نعني بها الميتافيزيقا، لا من حيث أنها فرع من فروع الأبحاث الفلسفية، وإنما من حيث أنها حياة تحاول فيها أنواع من القيم أن تؤكد ذاتها. فهي حاضرة في مختلف الأشكال الثقافية التي عرفها، ويعرفها الإنسان، وهي حاضرة في الأدب، وأساسا في اللغة التي قيل إنها "مأوى حقيقة الوجود".
إذا أخذنا الفلسفة بهذا المفهوم فما علاقتها بالأدب؟ هل هي تستغيث به لسد فراغ تعجز هي عن ملئه؟ هذه، على أي حال، هي الإجابة التي يظهر أن أديبا متميزا كميلان كونديرا يعطيها لهذا السؤال. يقول في "فن الرواية": "وبالفعل، فإن جميع الثيمات والموضوعات الوجودية الكبرى التي يحللها هايدغر في كتابه 'الوجود والزمان'، والتي يعتبر أنها أُهملت و'تُنوسيت' من طرف كل الفلسفة الأوروبية السابقة عليه، قد تم الكشف عنها وإظهارها وإضاءتها بواسطة أربعة قرون من الرواية. لقد اكتشفت الرواية، بطريقتها الخاصة وبمنطقها الخاص، المظاهر المختلفة للوجود واحدا تلو الآخر: فمع معاصري ثربانتيس تتساءل الرواية عن ماهية المغامرة، ومع صموئيل ريتشاردسون تشرع في تحليل ما يقع دواخل الإنسان، وفي الكشف عن الحياة السرية لعواطفه ومشاعره، ومع بلزاك تكشف تجذر الإنسان في التاريخ، ومع فلوبير تستكشف أرض اليومي التي ظلت إلى ذلك الحين أرضا مجهولة، ومع تولستوي تنكب على تدخل أثر اللامعقول في اتخاذ القرارات الإنسانية وفي تحديد السلوك البشري. كذلك تستقصي الرواية الزمن: اللحظة الماضية المنفلتة مع مارسيل بروست، اللحظة الحاضرة المنفلتة مع جيمس جويس، ومع توماس مان تتساءل الرواية عن دور الأساطير التي تتحكم في خطواتنا وتوجهها...".
قد نحتاج إلى بحث مطول للوقوف على حدود هذا النوع من الإجابات، وتكفي الإشارة هنا الى أن من الصعب التسليم بأن هناك وحدة بين التيمات الأدبية والقضايا الميتافيزيقية، وقد سبق أن أكدنا أن الميتافيزيقا لا تعنينا هنا من حيث هي قضايا، وإنما من حيث هي منطق للكائن وبنية للوجود، وهي، كما بيّن هايدغر، بنية أنتو-تيولوجية، فحتى إن كان ولا بد من ربط الأدب بالفلسفة، فمن المؤكد أن ذلك لن يتم عبر الثيمات والموضوعات، بقدر ما يتم عبر الاستراتيجيات، بحيث تتشابك استراتيجيا الفلسفة باستراتيجيا الأدب لتصبحا كتابة تستهدف مراوغة اللغة، وتقويض الميتافيزيقا، وتفكيك أزواجها.
النقد والترجمة
لو استعرنا عبارة للفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، لقلنا إن الفلسفة ستأخذ على عاتقها عندئذ "أن تجعل النقد يمتد". فإذا كان النقد ينصب مثلا على مفهوم المؤلف في الكتابة الأدبية، أو على جدلية الحضور والغياب في النص الأدبي، فإن التدخل الفلسفي يمكن أن يتناول المسائل ذاتها كي "يجعل الفكر يمتد"، ويبحث عما إذا كان ما يقوله الناقد عن المؤلف يمكن أن يمتد إلى مفهومات أكثر تجريدا كالذات الفاعلة، والملكية والخاصية والخصوصي: le propre, la propriété.
القول ذاته يصدق عندما يتعلق الأمر مثلا بقضايا الترجمة. لا أظن أن مسعى الفيلسوف، وهو يهتم بقضايا الترجمة، أن يُقصي التناول الذي يمكن لدراسة لسانية أو أدبية أن تقوم به في هذا المجال، مهمته في هذا الباب هي أن يجعل اهتمام هؤلاء "يمتد" إلى القضايا التي يطرحها الاستنساخ، وإلى مفهومات النموذج والتطابق والتكرار والتشابه والاختلاف.
كما لا ينبغي أن يُفهم من هذا التدخل نوعٌ من التمارين التطبيقية التي يخوضها الفيلسوف بعد أن يكون قد مارس استراتيجيته في مجاله الخاص.
إن هذا التدخل، على العكس من ذلك، قد يتخذ عندنا، إن لم نقل أهم مجال في الفكر الفلسفي اليوم، فعلى الأقل أحد أكثر مجالاته خصوبة. وقد سبق للمفكر عبد الله العروي أن بيّن، في المقدمة التي وضعها للترجمة الجديدة التي قام بها هو نفسه لـكتابه "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"، كيف أن النقد الإيديولوجي قد اتخذ الأدب قنطرة عبور في الثقافة العربية المعاصرة. يقول: "إن ثلثي، بل قل ثلاثة أرباع النقد الإيديولوجي، يظهر عندنا في شكل نقد أدبي، أي يتخذ الرواية والقصة والمسرحية كوسيلة لترويج الأفكار السياسية والاجتماعية... لا ننسَ أن كلا من محمد عبده وسلامة موسى وطه حسين روجوا لأفكارهم التجديدية بواسطة دراستهم للأدب العربي، قديمه وحديثه".
لسنا مجبرين، في طبيعة الحال، أن نقول إن مهمة الأدب هي الترويج لأفكار اجتماعية وسياسية، إلا أننا لا نملك إلا أن نسلم أن كثيرا من الأفكار التحديثية لم تمر في ثقافتنا عبر كتاب في الفلسفة ككتاب "الزمان الوجودي" لعبد الرحمن بدوي، وإنما بالأولى عبر ما راج حول كتاب مثل كتاب "في الأدب الجاهلي" لطه حسين.
وربما على النحو ذاته، يمكن أن نبرر الأهمية التي اتخذتها التفكيكية في الولايات المتحدة الأميركية داخل أقسام الدراسات اللغوية والأدبية. ففي وسط تهيمن عليه روح الوضعية الجديدة، لا يتخذ تاريخ الفلسفة، الذي يشكل المادة الأساس التي اشتغل عليها التفكيك في موطنه، لا يتخذ ذلك التاريخ أهمية كبرى، فلا يتبقى للتفكيك، والحالة هذه، إلا أن ينهج قنوات أخرى ليمارس فعاليته.
في هذه الحال، يغدو الدرس الأدبي ميدانا خصبا لتقويض الميتافيزيقا وتفكيك أزواجها، خصوصا إذا كان ذلك الدرس يرصد المنطق الذي يحكم نصوصا طالما ألفنا "حفظها"، من غير أن نعمل على إذكاء حدّة التوتر بينها وبيننا.