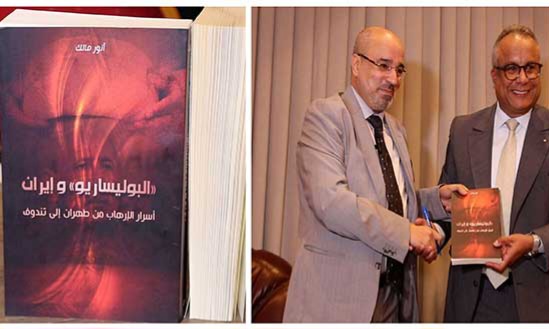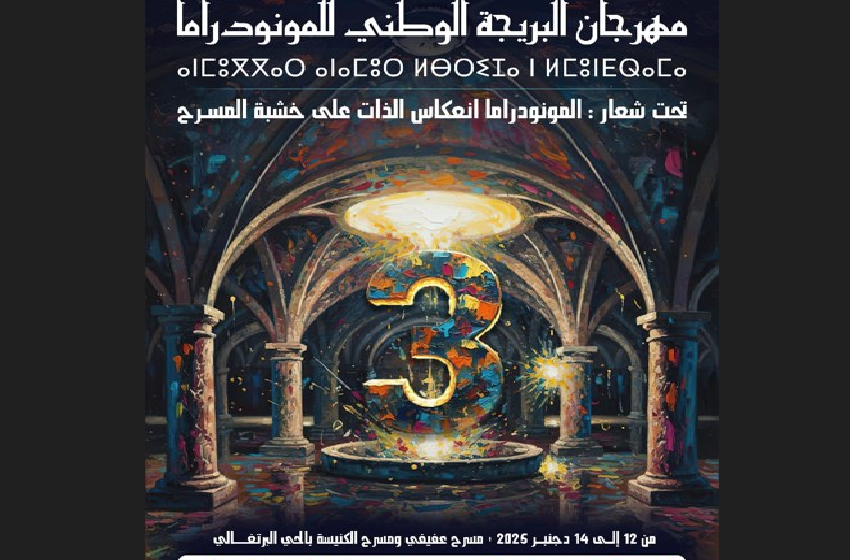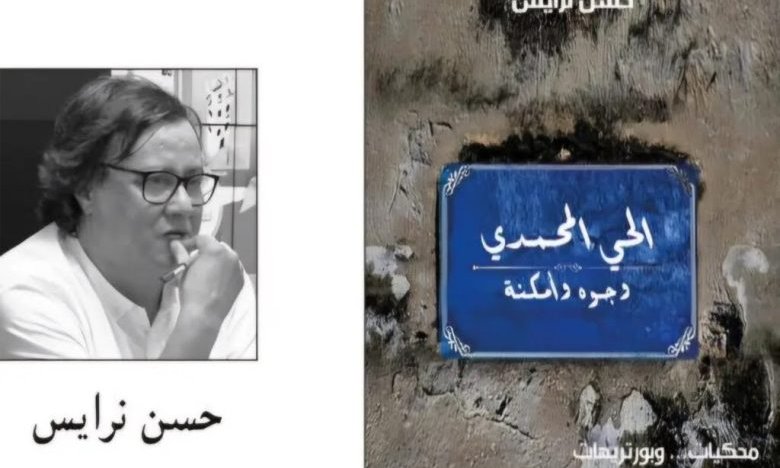لا يحتاج المشهد الإعلامي المغربي إلى مجهر لكشف اختلالاته؛ فالأرقام وحدها كفيلة بتعرية واقع الدعم العمومي الذي قفز في ظرف سنوات قليلة من 5.5 مليار سنتيم سنة 2019 إلى 20.5 مليار سنتيم سنة 2020، وُصولا إلى 26.5 مليار سنتيم اليوم، مع توقعات ببلوغه 27.7 مليار سنتيم سنة 2026.
هذا الارتفاع الهائل في “كعكة” الدعم لم ينعكس لا على جودة الصحافة ولا على قوتها المهنية ولا على استقلاليتها. بل انعكس في شيء واحد فقط: مزيد من الصمت.
مؤسسات إعلامية عملاقة، غارقة أصلا في عائدات الإشهار العمومي والخاص، اختارت أن تقف على الهامش أمام فضيحة لجنة الوزير بنسعيد.
صمتٌ مُخجل يطرح سؤالا جوهريا: هل هذه المؤسسات حرة أم أنها تُدجَّن بواسطة المال العام؟
أولا: الدعم.. حين يفقد وظيفته ويتحوّل إلى جزرة
الدعم العمومي في فلسفته الأصلية آلية لتقوية الصحافة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية، لا لشراء ولائها. لكن المعادلة انقلبت: كلما ارتفع الدعم، كلما اتسع الصمت.
لم يعد الدعم وسيلة لبناء استقلالية التحرير، بل أصبح أداة غير معلنة لإعادة تشكيل المجال الإعلامي تحت منطق “الجزرة” لمن يطيع و"العصا" لمن يجرؤ.
فكيف ننتظر من مؤسسة تعيش على التحويلات العمومية أن تُحرج الجهة التي تموّلها؟ وكيف نطلب من صحافي ينتظر أجره من حسابات وزارة أن يكتب تحقيقا يزعج الوزير؟
ثانيا: الرقابة الذاتية المدفوعة أخطر من الرقابة الرسمية، أخطر ما يُهدد الصحافة اليوم ليس الرقابة القانونية، بل الرقابة الذاتية. هذه الرقابة لا تُفرض بقرار ولا بقانون، بل تُزرع داخل الصحافي نفسه.
حين يتلقى الصحافي أجره مباشرة من الدولة عبر حوالات شخصية - رغم اشتغاله في مقاولة خاصة - تتشكل علاقة غير معلنة: الدولة هي ربّ العمل الحقيقي، والمؤسسة مجرد وسيط إداري، عندها يصبح الصحافي مترددا أمام كل موضوع حساس، متوجسا من كل سطر يمكن أن يفسَّر كجرأة زائدة.
هنا، يتحول الأجر إلى سيف معلّق فوق عنقه، والتردد إلى جزء من “الأخلاقيات الجديدة” للمهنة.
لا حاجة لاستدعائه أو تهديده أو توجيهه.
يكفي أن يتذكر مصدر راتبه ليبدأ بالكتابة بقلم مكسور.
هذه الرقابة الناعمة أخطر من الرقابة الصلبة، لأنها ليست مفروضة من الخارج، بل من الداخل، إنها ترويض ذاتي، وتكميم إرادي، وصمت مُبرمج.
ثالثا: مؤسسات قوية ماليا، ضعيفة مهنيا
السؤال الذي يفرض نفسه:
لماذا تحتاج المؤسسات الكبرى، المهيمنة على سوق الإشهار العمومي والخاص، إلى كل هذه الحصص من الدعم؟
الإجابة واضحة:
لأن الدعم في صيغته الحالية ليس “دعما ماليا”، بل “ضمان ولاء”.
ومن يضمن ولاءه، يضمن سلامته، ومن يضمن سلامته، يضمن صمته.
وهكذا يتحول المشهد الإعلامي إلى فضاء مملوء بأصوات مرتفعة حول التفاهة، ومنخفضة حدّ الاختفاء حين يتعلق الأمر بالمساءلة أو فضح الفساد أو كشف الارتباكات الحكومية.
رابعا: دعم بلا معايير.. إعلام بلا وظيفة
ما لم يُربط الدعم العمومي بمعايير موضوعية - شفافية، مردودية، تحقيقات، خدمة عمومية، التزام أخلاقي - فإنه سيظل مجرد مقابل للصمت، وليس رافعة للتطوير.
ليس المطلوب إلغاء الدعم، بل تحريره من الوظيفة السياسية التي التصقت به.
فالدعم حين يُصرف بلا شروط صارمة، يصبح مجرد تعويض عن عدم الإزعاج.
وهنا يكمن الخطر الأكبر:
إعلام بلا وظيفة اجتماعية، بلا أجندة عمومية، بلا روح نقدية.
إعلام فاقد للجرأة، فاقد للمبادرة، فاقد للشجاعة.
الخلاصة..
إن ما نعيشه اليوم ليس أزمة دعم، بل أزمة رؤية.
ليست أزمة مال، بل أزمة ثقة.
ليست أزمة قوانين، بل أزمة استقلالية.
إنها بكل اختصار أزمة إرادة سياسية
أزمة ديموقراطية حقيقية
أزمة إصلاح وأزمة سيطرة
الصحافة التي تُموَّل من أجل الصمت ونشر التفاهة لا يمكنها أن تخدم المجتمع.
والصحافي "المستقل" الذي يعيش تحت سيف الأجر العمومي لا يمكنه أن يكون ضميرا حُرّا.
والمؤسسة المستقلة التي تخاف من الوزير لا يمكنها أن تحمي الديمقراطية، ولو بحدّها الأدنى.
إذا كان الدعم العمومي قد تحوّل إلى أداة ترويض، فإن استعادة حرية الصحافة لن تتم إلا بإعادة بنائه وفق معايير صارمة، شفافة، مهنية، وأخلاقية، تجعل ولاء الصحافي للمهنة وللمجتمع وللصالح العام،
لأنّ الصحافة التي تُشترى لا يمكن أن تُصلح.