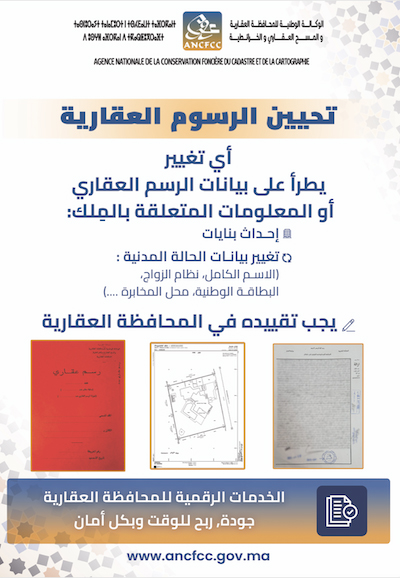حضور المرأة داخل إطارات المجتمع بالبلدان الإسلامية ومؤسساتها لا زال مطبوعا بالرفض بسبب ما تتعرض له من تهميش وظلم وتعنيف، إضافة إلى فقدان الكرامة جراء سلوكات متوحشة تكاد اليوم تنقلها جل منابر الإعلام بشكل دائم، وهو ما يفسر صرخة نسائية في وجه مجتمعاتها كرفض للرضوخ لطرق وأساليب الإمعان في توغل النزعة الذكورية.
هذا هو الوجه المُتخَفي في ثنايا العقلية المُوجهة للسلوك في الحياة اليومية، والمحددة لطريقة اتخاذ الموقف من المرأة وتحركها في المحيط وتعاملها مع باقي مكوناته. وهذا هو ما يعتمل في الواقع من مماسات وتصرفات تشكل علامات دالة على مدى ابتعاد الممارسات عن البعد الإنساني كَمَنَاط لقواعد تنظيم الوجود، بما يدعو إلى تفجير قضايا كبرى تخص تدبير العيش المشترك على قاعدة المواطنة وطرق تنشئة الأفراد ذكرا وإناثا على قاعدة منظومة قيم إنسانية.
وهذا ما يجعل المرأة في كل الوضعيات والمواقف والأوقات عرضة للإجبار والضغط والحرمان من اتخاذ القرار والاختيار، ويرسخ لدى النساء الإحساس بعدم القدرة على التمتع بكافة الحقوق والحريات على قدر مساو للرجال، ويشعرهن بكونهن مهددات وغير آمنات ومحبطات في بيئة غير مستعدة حتى للإنصات لمعاناتهن. بل ويزيد الطين بلة حين يتأثث المشهد بوجود قوى محافظة لا زالت مُمْعنَة في الميل إلى حرمان المرأة من حقوقها وحرياتها، بل وحتى إهانتها وتبخيس أدوارها داخل الأسرة، ومن خلالها في قلب المجتمع وإطاراته ومؤسساته بشكل عام.
فقضايا المرأة المعرضة باستمرار للوقوع في وضعيات مأساوية ولمواجهة مواقف عدوانية، تتطلب مجهودا من حيث إبراز الدور الكبير للحكومات في غرس القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الأجيال الناشئة على أساس المواطنة، ومن حيث توضيح أهمية الفلسفة المُؤطرة لصياغة القواعد التشريعية والقانونية على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص، ومن حيث ضمان وإعمال الحقوق والحريات في واقع المعيش اليومي دون أي تمييز. خاصة وأن الدونية والتهميش والتعنيف والحط من الكرامة تعتبر جرائم شنيعة وبشعة ضد إنسانية الإنسان، لما ينتج عنها من مآسي نفسية ومادية واجتماعية لا تطال انعكاساتها السلبية المرأة لوحدها، بل تتعداها لتطال المجتمع برمته للأسف الشديد. ويتفاقم حجم معاناة النساء حين يلمسن غياب أي ردود فعل داعمة لهن ومتضامنة معهن، سواء من قبل الأهل والأقارب والجيران أو من طرف الساهرين على إنفاذ القانون.
وكأن الجميع متواطئ على ترك سفينة المرأة، وعلى أوضاع نساء يزج بهن في متاهات فقدان الكرامة. وهو ما يجعل البلدان الإسلامية في وضعية التنافي مع المنظومة القيمية الحقوقية الكونية، ويدفع بالعلاقات الاجتماعية داخلها إلى التخلف بمسافات ضوئية تفصلها عن قواعد وضوابط العيش المشترك في ظل منظومة معززة للذات. بما يحتم على جميع الفاعلين استيعاب حجم مسؤولية إدراك انتظارات الشعوب من الحكومات والنخب تجاه المرأة ومطالبتها بالتحرر والانعتاق، بدل التراشق بالشعارات غير المؤدية إلى مخرجات عملية وإيجابية لهذا المأزق التنموي المربك والمسيء للسمعة.
فالمرأة حسب أغلب الوضعيات وأعمها داخل هذه البلدان لا تتذوق طعم الحرية، وتتعرض لأسوأ المعاملات، وتخضع لعلاقات فاقدة للاحترام وخارجة عن نطاق الأخلاق المرعية، بما يفقدها مقوم تقدير الذات ويلقي بها في غياهب استبطان العجز عن الاعتزاز بنفسها داخل محيطها. فهي تتعرض لضغوط وجبر داخل المؤسسة الزوجية والأسرة والسياقات المهنية والشارع العام، دون مراعاة لحقها في اتخاذ قرارات مصيرية في شؤونها الخاصة والقبول بالعيش داخل علاقات موسومة بالتعنيف وفقدان الإحساس بكينونتها. كما تتعرض للحرمان من التمتع بحقوقها دون مراعاة لإنسانيتها، وتتوسم في بلدانها أن تكون في مستوى ضمان حقوقها ومحاربة الأفكار والنزعات والميول والممارسات التمييزية التي تشعرها بوضعها الدوني. خاصة في وقوع حالات الاغتصاب القصوى التي التي تطرح تساؤلات عريضة بخصوص أحاسيسها ومشاعرها؛ سواء من حيث تمتعها بصفة المواطنة داخل مجتمعات لا تضمن لها الاستقرار والنمو الطبيعي والعادي كأنثى، أو من حيث التعبير عن غياب السلوك التضامني الذي بإمكانه التخفيف من معاناتها وآلامها.
وضع البلدان الإسلامية يتطلب الإسراع بإعادة النظر في كيفيات التعاطي مع مشاكل المرأة التي هي في الأصل مشاكل مجتمعية ذات صلة قوية بالتنمية وتعزيز قدرات الأفراد وتيسير سبل اندماجهم في المحيط، بشكل شامل وعلى نحو مغاير لما يتم اليوم من اتخاذه من إجراءات شكلية غير قادرة على ملامسة عمق القضية، فالأمر مرتبط أساسا بتحسين شروط عيش في ظل مواطنة كاملة غير منقوصة وغير خاضعة لأي استثناء أو تمييز.
فعديدة هي الأسباب والمسببات التي تدفع إلى تحسين وضع المرأة داخل البلدان الإسلامية وتعزيز مكانتها وقدراتها وأدوارها، وكثيرة هي المشاكل التي تتخبط فيها المرأة بفعل التحولات الجارية في الحياة المعاصرة، ومتنوعة هي تلك التحركات المدنية والسياسية التي دقت ناقوس الخطر وطالبت بإعادة النظر في طبيعة وشكل المعالجة التي يتم اعتمادها لتجاوز الاختلالات التي تنعكس على أوضاع النساء في معيشهن اليومي.
وإذا كانت الجهود، التي تبذل في إطار الحد من التأثيرات السلبية للنزعة الذكورية على واقع المرأة وتكسير قيود اندماجها السلس في مخططات التنمية البشرية والاجتماعية مقدرة من حيث استدراك الانتباه لخطورة الظواهر المرتبطة منها، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب استمرار العديد من العقبات والصعوبات. خاصة وأن أمر الانتقال من تلك المقاربات القائمة على إجراءات تعديلية جزئية بل وشكلية في العديد من الحالات يلزمه أن يكون مؤطرا بتصور متكامل لضمان حق المرأة في مواطنة كاملة تكفل شروط تواجد متساو للنساء جنبا إلى جنب مع الرجال داخل الفضاءات الخاصة والعامة، وهو ما يتطلب تعميق المنجز وترصيد التراكم ودعم هذا الورش الإصلاحي باتخاذ مزيد من التدابير الهادفة إلى ملامسة أفق الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة.
فالقبض على ناصية المشروع الإصلاحي في هذا الباب يجد مدخله في الاستجابة العملية والدقيقة لمجموع المتطلبات والمقتضيات الكفيلة بضمان حقوق وحريات هذه الفئة من المواطنين، دون الخضوع للتشويش وللارتهان لمبررات الرفض والمحافظة والانغلاق، التي في الغالب الأعم تكون مشحونة بلمسة الرغة في خدمة أجندات إيديولوجية وسياسة على النقيض من المشروع المجتمعي الحداثي والتنموي، خاصة تلك المتمسحة بلبوس دينية أو مذهبية متجاوزة بفعل التحولات الجارية بمنطق التطور البشري في الزمان والمكان. خاصة مع استحضار الوعي بأن هذا المنحى الرافض لإصلاح أوضاع المرأة في المجتمعات الإسلامية أثبت في غير ما مرة أنه لا يقيم وزنا لاعتبارات الواقع الضاغطة اليوم على النسيج المجتمعي برمته، وكشف عن قصور واضح في التعاطي بموضوعية مع قضايا ومشاكل اندماج المرأة في محيطها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بمنظور جديد يجيب على معضلاتها ويبحث عن طرق وكيفيات تحسين شروط عيشها. خاصة مع وضوح الرؤية فيما يتعلق بعرقة مكانتها الدنية داخل الأسرة لمشاركتها في الحياة الاجتماعية بشكل سليم ومساو للرجل، بالرغم من كونها أصبحت معنية بحل المشاكل المادية للأسرة وتوفير متطلبات العيش للأولاد، وبالمشاركة في الحياة المهنية والسياسية جنبا إلى جنب مع الرجل.
وبالقدر الذي تزايدت وتعاظمت مسؤوليات المرأة تجاه محيطها العائلي والأسري، وبالقدر الذي تعددت وتنوعت واجباتها تجاه المجتمع والدولة، بالقدر الذي لا زالت تعاني من مشاكل معقدة بفعل عدم مواكبة مجمعاتها للتطوارت الحاصلة في الواقع، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال استمرار ظاهرة التزويج المبكر للنساء وتقييد حرية اختيارهن وتعرضهن للتعنيف الزوجي وتعدد الزوجات والطلاق غير المبرر وإثقال كاهلهن بإعالة الأولاد وحضانتهم دون تمكين مادي ولا معنوي. وبفعل التقاعس والتقصير في أداء المهام، وقع تراجع خطير لدى بعض النخب بفعل الاستقطاب والتجييش، فتمت الاستعاضة عن القراءة المتأنية والفاحصة لواقع المرأة وعن الجد والكد في إيجاد الحلول بالخروج إلى الشواع والاحتجاج تحت قيادة المدعين للاختصاص الشرعي، ورفع الشعارات الفضفاضة التي لا تجد لها من تصنيف في قواميس التعبير إلا في إطار الرغبة في خوض غمار تنافس سياسي بدون عمق اقتصادي وتنموي، ووقع الإهمال لضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية وتفادي التساؤل عن مدى صلاحية استمرار بعض القواعد المتجاوزة واقعيا وعمليا. وهو ما دفع في اتجاه تغيب شرط النقاش العمومي الهادئ ذي النجاعة والمردودية في استخلاص الدروس واستنتاج المواقف واستخراج قواعد وأحكام جديدة ومجددة، بناء على ما يقتضيه ترجيح المصلحة المجتمعية العامة وما تتطلبه شروط تيسير العيش في عصرنا هذا.
وإذا كان من نقاش رصين حول وضعية المرأة ومساواتها للرجل في البلدان الإسلامية، فهو في اعتقادنا لابد أن يكون ـ من حيث المبدأ ـ مرتبطا أشد الارتباط بمحددين أساسيين هامين: يتمثل الأول في علاقة المساواة بحق كل المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق والحريات كقاعدة ارتكاز أساسية لأي تحول تعرفه هذه البلدان، وهي اليوم على درب قطع بعض الأشواط من حيث العمل على تجسيد معالمه على أرض الواقع بشكل متفاوت فيما بينها، بالرغم مما يعترضها من عقبات وحواجز، وبالرغم من أن حجم الإمكانيات قد لا يكون موازيا أو في نفس مستوى سقف التحديات المطروحة والإكراهات القائمة في الواقع، وبالرغم من وجود مشاكل عدة على مستوى الحكامة في تدبير الممكن والمتاح من هذه الإمكانيات، وبالرغم من وجود مقاومة ذات طابع محافظ داخل فئات وشرائح مجتمعية، وبالرغم كذلك من وجود بواعث قلق بارزة بخصوص احتمال الانتكاس والتراجع إلى الوارء والتفريط فيما تم ترصيده من مكتسبات ف هذا الشأن.
ويتجسد المحدد الأساسي الثاني في علاقة قيمة المساواة بالوظائف المؤسساتية المعنية بإنفاذ مضامين ومحتويات مشاريع التسيير والتدبير للسياسات العمومية وفق القواعد والمساطر المعمول بها في إطار الارتقاء بالأدوار والمهام المنوطة بالدولة، والملزمة بها تجاه مجتمعها. فأن تكون المجتمعات الإسلامية في خدمة ترسيخ وتعزيز مفهوم حق المرأة في العيش على أساس مساواتها للرجل، سواء في سياق الديناميات السياسية والحقوقية، أو في سياقات الاهتمام الكوني بهذا الحق وقواعد التفكير في بلورته وتحسين شروط تفعيله على أرض الواقع، أو في سياق تحديد نقط ارتكاز عملية تجسيد معانيه في كل تفاصيل العلاقات والتفاعلات الجارية داخل المجتمع، فهذا يعني أنها ملزمة بتبني مفهوم المواطنة بما تعنيه من كونها معبرة عن مجمل العلاقات والتعاقدات التي تربط الفرد/المواطن والمواطنة بمؤسسات الدولة على قاعدة ضمان الحقوق والحريات. وهذا يعني ما يعنيه على مستوى ما يتطلبه الأمر من جهد وعمل في إطار المساهمة من أجل تنامي الاهتمام بالبعد الإنساني وبشروط تواجده السياسي داخل المجتمع. كما أن له من الدلالات ما يلزم الشعوب باقتفاء آثار الاهتمام بمفهوم التاريخ ومسارات تطوره في مجال تمكين الكائن البشري من حقوقه وحرياته بشكل عام، وكذا في مجال تجسير الهوة الساحقة بين الرجل والمرأة على مستوى التمتع بهذه الحقوق والحريات بشكل خاص، وهو ما يفرض بالضرورة وجود إرادة فعلية في صياغة قواعد قانونية ناظمة لعلاقات الأفراد والجماعات والمؤسسات. وبهذه الرؤية والخطوات والإجراءات تصبو الشعوب إلى أن تكون أقرب إلى الاهتمام الإنساني والاجتماعي والسياسي بمآسي الإنسان عبر مختلف المحطات التاريخية التي زجت به في أنفاق ارتكاب أبشع الفظاعات في حقه، امرأة كانت أو رجلا، سواء بمبرارت تاريخية أو حضارية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية أو جنسية...
لذلك، ومن أجل مساواة فعلية للمرأة مع الرجل، فالأولوية اليوم لترسيخ البعد التعددي الاختلافي على قاعدة مفهوم المواطنة، والتوجه مباشرة إلى تفكيك ونقد الأسس التراثية التي شكلت دعائم الفكر المعادي للبعد الإنساني في تنظيم العلاقات داخل المجتمع الواحد، وبناء العلاقات من جديد على أساس أن للبشر راهنا ومستقبلا مشتركين. والتواصل هو أداة لتبديد الحواجز التي تنتصب عائقا أمام الأفراد والجماعات وأساس للوحدة التي تربط بينهم وتضمن انتماءهم للمجتمع الواحد وللإنسانية جمعاء. ومن المنطقي الانطلاق من تصور مكانة الإنسان في التاريخ بعيدا عن تعميم أفكار دينية أو جنسية أو عرقية أو لغوية على التاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله. والمطلوب هو انخراط الفاعلات والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين في دينامية التحولات الجارية بدون افتعال للتعقيدات. فإذا كانت المعرفة الإنسانية قد سلطت الضوء عبر مراحل تطورها التاريخي ـ بناء على ما تراكم في خزان حضارات مختلف الشعوب والأمم ـ على معنى المواطنة بما هي تعبير عن مجمل العلاقات والتعاقدات التي تربط الفرد/المواطن والمواطنة بمؤسسات الدولة حقوقا والتزامات باعتباره شخصية قانونية تساهم في تدبير الشأن العام، فإننا مطالبون بالبحث عن سبل تجسيد هذا المعنى على أرض واقع مجتمعاتنا.
وفي اعتقادنا، فإن أهم نقط الارتكاز التي ينبغي الانكباب عليها، وترسيخها وتقوية شروط وظروف تواجدها الاجتماعية والثقافية، تتمثل في أهمية إدراك الإنسان نفسه كمواطن قبل كل شيء، وضرورة وضع الإنسان شرطه السياسي نصب عينيه، وتحفيز الإنسان على مشاركة أمثاله من المواطنات والمواطنين بدل التعالي عليهم، وتأهل الإنسان ذاتيا للتفكير والمشاركة في صناعة حاضر ومستقبل بلدانه ولاكتسابه صفة المواطن أو المواطنة داخلها. فأن تكون المجتمعات في خدمة ترسيخ وتقوية وتعزيز مفهوم المواطنة، معناه أنها ملزمة بالعمل على توفير شروط دمج نقاط الارتكاز هذه في كل العلاقات القائمة بين مكوناتها، وفي كل التفاعلات الجارية بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، بتنشئة اجتماعية قائمة على المواطنة، حيث لا فرق بين رجل وامرأة، وحيث لا مجال للتمييز ضد المرأة بناء على ما تراكم في الموروث من تقاليد وعادات ما عادت مجدية.
فمطلب المساواة بين المرأة والرجل ليس ترفا فكريا ولا مجالا للمزايدة السياسية، ولا قضية للتصريف المغالي والمتعصب لمواقف دينية أو عرقية أو حتى قانونية، بل هو مطلب حاضن لرؤية تصحيحية للمسار التاريخي للعلاقات داخل المجتمعات، ومعبر عن فلسفة جديدة للعيش المشترك في الحاضر وعن استشراف أفق المستقبل، ومجسد لاستراتيجية عامة معنية بإحداث تغيير إيجابي في مجمل العلاقات والتعاقدات من أجل المساهمة الجماعية والمشتركة في تدبير الشأن العام. فهل تعمل الدول الإسلامية على الترسيخ المؤسساتي لثقافة المواطنة، لكي تفسح المجال لوضوح مطلب المساواة؟ وهل تمكنت الإطارات والمؤسسات من العمل على تجسيد معاني المواطنة في كل مفاصل هياكلها الإدارية والتدبيرية لكي تصبح المساواة ضرورة واقعية ومجتمعية وحيوية؟ وما هي التراكمات المحصل عليها اليوم في مجال ترسيخ ثقافة المواطنة داخل كل من الدول والمجتمعات، لكي يتم رفع الحيف على المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها؟ وكيف هو حال التنشئة الاجتماعية والتربية الوطنية والبحث العلمي؟ وكيف هو الحال على مستوى الحياة الاجتماعية والأسرية؟ وكيف هو الحال على مستوى العلاقات والتفاعلات بين كل الأفراد والجماعات والمؤسسات؟
إذ كلما كانت المؤسسات والإطارات مراعية لحضور فكرة المواطنة عبر وعي الذات لدى الإنسان من خلال المجموعة، وعبر تحديد علاقة الفرد بمجتمعه، وعبر تحديد علاقة الفرد بالدولة، وما ينتج عن ذلك كله من علاقات وارتباطات، كلما كان المجتمع مُدْمجا لمقاربة المواطنة وفاسحا المجال لمطلب المساواة بين المرأة والرجل كي يتجذر أكثر في الذهنيات والعقليات، وكلما كان غير مراع لتلك المحددات، كلما كانت النتائج عكسية. فغياب تصور ناظم لمقاربة المواطنة، وافتقاد الخيط الناظم بين هذه المقاربة ومطلب المساواة بين المرأة والرجل على مستوى الجانب المعرفي، وعدم وضوح الرؤية الموجهة للتصريف التربوي والثقافي والاجتماعي والسياسي الدقيق لمقاربة المواطنة، يطرح السؤال عريضا حول مدى التحقق من الوصول إلى عملية التصحيح لما تم تمثله بخصوص ثقافة المواطنة بواسطة إجراءات تمكن من التحكم في عمليتي التنشئة والتربية بفضل التدخلات التي تصحح ذلك المسار، سواء تعلق الأمر بمحتوى التنشئة والتربية أو بطرائقهما أو بمردوديتهما وانعكاسهما على المواطنات والمواطنين.
إن إحدى المشكلات المطروحة في مجالي التنشئة الاجتماعية والتربية المستدامة تكمن في إعادة تصحيح العلاقات بين الفرد والدولة، وتنمية الإحساس بالدولة وتعميقه لدى الفرد كمؤسسة تحكم وتنظم الجميع ويشارك فيها الجميع ولها هدف هو مصلحة الجميع والخير العام. وفكرة الديمقراطية نفسها تصبح غير ذات معنى مع غياب الوعي بالدولة وعدم وجود أساس فلسفي لفكرة الدولة نابع من الثقافة المحلية نفسها ومن خلاصات التجارب الناجحة في بلدان العالم. فزيادة منسوب معنى المشاركة الاجتماعية في التنشئة والتربية، هو المعنى الذي ينبغي أن يكون حاضرا بقوة، وهو الذي يكون مؤداه تربية الفرد على المشاركة، وتقريب الفرد من المؤسسات الاجتماعية الفاعلة، حيث لا فرق في هذا بين امرأة ورجل.
والمساواة بهذه المعاني كلها كالمواطنة ينبغي أن تحضر من خلال التركيز على علاقة الأفراد ـ نساء ورجالا ـ والجماعات والمؤسسات بالقانون، والنزاهة والشفافية والوضوح في كل الخطوات والعمليات والتدابير والإجراءات التصحيحية والإصلاحية، والتركيز على حقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين والحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي، والمشاركة السياسية عبر الحق في الخدمة والمشاركة في إدارة البلاد والحق في الترشيح والتصويت وحرية الإعلام والتعبير والمسؤوليات تجاه المجتمع وتطوير فهم الروابط التي تجمع بين الحقوق والمسؤوليات، وتطوير الحس تجاه العلاقات المعقدة بين مختلف قطاعات المجتمع الديمقراطي.
هناك ضرورة ملحة لأن تتقاسم النساء والرجال سلطة اتخاذ القراارت الخاصة بالشؤون العامة، لأنه ببساطة كلاهما يشكل المجتمع سويا، وهم وهن ـ في نهاية المطاف ـ المعنيون والمعنيات بالقرارات السياسية. فما يمكن اعتباره أساسا للمطالبة بمساواة المرأة والرجل يكمن في رؤيتنا التي تنطلق من الرغبة في إقامة نظام أكثر إنصافا وعدالة، ويكمن في الإرادة القوية والجامحة في أن يكون هذا النظام متمتعا بتماسك اجتماعي قوي؛ تعزز وشائجه كل العلاقات والتفاعلات الجارية بيننا كأفراد وجماعات ومؤسسات، ويكمن أيضا فيما يمكن أن نتحلى به من شجاعة سياسية قادرة على إحداث تقدم مستدام قابل للقياس نحو مساواة بين المرأة والرجل في كل مواقع القرار. فالارتقاء بمنظورنا للمساواة يبدأ من حيث قدرتنا على استبدال النماذج السياسية القائمة على أساس التمييز والعمل على فتح فضاءات أرحب من حيث إنصاف النساء في مجالات اتخاذ القرارات الجماعية، محلية كانت أو جهوية أو وطنية. ولعل هذا المنظور هو الكفيل ـ ليس لوحده طبعا ـ بإضفاء طابع الشرعية أكثر على تمثيلية النخبة السياسية في بلادنا، والابتعاد عن التحليق في فضاءات الاستفادة من الامتياز أو الريع السياسي.
إن الانتقالات الإيجابية على مستوى الدمقرطة والتحديث داخل المجتمعات، وكذا التحولات الاجتماعية والثقافية والتربوية، كانت ولا تزال في حاجة إلى تفكير وتنظير وتخطيط وبرمجة وأجرأة، وهو ما يستدعي التحلي ببعد النظر وطول النفس. وإذا ما تم استحضار مطلب المساواة كمفصل من مفاصل هذه الانتقالات والتحولات، فإننا نجد بأن كل أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة منغرسة ومتجذرة في الذهنيات والعقليات وفي نسيجنا المجتمعي وفي غالبية تجاربنا وتفاعلاتنا اليومية، بالشكل الذي يصبح معه التفوق الذكوري يحتل مساحة كبيرة من التفكير الجماعي والمنظوارت الفردية والتعاملات الجارية. فعدم حضور المرأة في السياسة والعمل السياسي بالدرجة المطلوبة غالبا ما يعزى إلى ذاك التوزيع المنطلق أساسا من فكرة أن المرأة مكملة فقط لأدوار الرجل، وبالتالي فهي تستبعد من دوائر اتخاذ القرار. وكثيرا ما يتم رده إلى أن خشونة الحياة السياسية غير ملائمة للنزعة العاطفية للنساء المتصفات بالرقة والحنان، وفي بعض الحالات يفسر على قاعدة أن اهتمامات المرأة في المجال السياسي ليست كبيرة مقارنة مع اهتمامات الرجل..
وأمام مطلب المساواة ينتصب البعض واقفا مدعيا تارة الأولوية للتصدي لحل مشكلات أخرى أكبر، وأن الأمر يتطلب تحليا بالصبر أكثر، وأن إجراءات التمييز الإيجابي من أجل تيسير إدماج المرأة أظلم وأحقر، وكل هذا يخفي رغبة حثيثة في عرقلة مسار النساء للوصول إلى مراكز القرار. وهي كلها مبرارت ومسوغات للعمل على إعادة إنتاج نظام سيء مبني أساسا على عقدة التفوق الذكوري، واختزال النظر إلى المرأة من زاوية الدونية مقارنة بالرجل. وهو ما يعطل آليات مساءلة أشكال وأنواع اختلال التوازن في النظام العام وأوجه التمييز ضد المرأة.
كل طرق وكيفيات وصيغ العرقلة والفرملة في مجتمعاتنا اليوم، وخاصة منها تلك التي تطال مطلب المساواة، لا يمكنها إلا أن تزيد تعقيدا لحل مشكلة التمييز ضد النساء، وتعمل على إعادة إنتاج نظام تبعية النساء للرجال، وهي في أحسن الحالات تعمل على إرجاء حل المشكل وتعطيل تفعيل آليات التنمية والدمقرطة والتحديث بالنسبة للمجتمعات بصفة عامة. والحال أن سعي الدول والمجتمعات معا إلى تيسير شروط وظروف استفادة النساء من التمثيلية السياسية والحد من نسب التمييز ضدهن وإعادة الاعتبار لهن بدل إقصائهن وتهميشهن، سيعمل على استعادة العمل السياسي لمشروعيته، وهو أمر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لهذه البلدان على مستوى مواكبة مسار التطور والعصرنة والتحديث، ومحفز قوي للأجيال الحاضرة من أجل امتلاك الجرأة الكافية والقوة الاقتراحية اللازمة لتجاوز التقديرات والترجيحات السالفة المحددة لاختيار طبيعة وشكل التعديلات المدخلة على قوانين الأسرة، ولمواجهة معضلة التعصب الديني والمذهبي في نمط التفكير الفقهي السائد.
فمنطق التطور يقتضي التكيف التدريجي مع مستجدات الواقع والاستفادة من خلاصاته، ويفرض طرح إشكالية الملاءمة بينه وبين القواعد التشريعية المؤطرة له، وإلا أصبحت القاعدة التشريعية مُنمطة ومغلفة ومحنطة للواقع، ومحدثة للعديد من الثغرات والنواقص، وغير قادرة على الحد من السلوكات الخارجة عن قيمه وأعرافه. وهذا بالضبط ما يدفع إلى عدم الالتزام بالضوابط القانونية داخل مجتمعات اليوم، ويدعو إلى إعادة النظر في وضع المرأة وحل مشاكلها، في إطار ما تراكم من قابلية للانفتاح والتنوير. خاصة وأن الدين الإسلامي لا يدعو إلى التقوقع على الذات والتحجر للتخلف والتموقع في صفوف الرفض والمناهضة للاجتهاد، بل قد يفرض في شروط عيشنا هاته المساهمة الفاعلة في بلورة قيم حقوقية وإنسانية ذات طابع عالمي، من خلال الموروث الديني والثقافي الموسوم بالغنى الذي ينبغي توظيفه.
وفي هذا المقام لابد من التأكيد على أنه يكفي أن يقوم المجتهدون ببذل الجهد الكافي واللازم للإجابة عن المشاكل القائمة في الواقع، وتفادي الاكتفاء بالوقوف عند النصوص وظاهرها، وعند حدود قراءة منتوج السلف، والانفتاح على المقاصد التشريعية العامة، وإعمال العقل والتفكير بما يناسب معطيات وخصوصيات العصر، لتنال المرأة ما تستحق من كرامة وحرية ومساواة، ولتتبوأ مكانتها داخل المجتمع، ولتحصل على ما يلزمها من تقدير للذات داخل محيطها، ولتتعزز قدراتها على التفاعل الإيجابي والمثمر مع الرجل، ولتتقوى وظائفها وأدوارها داخل الأسرة ومختلف الإطارات والمؤسسات. فالضرورة اقتضت أن تنبني العلاقة الزوجية على مفهوم التعاقد، وعلى ألا يُترك الإنسان لغرائزه فتنطلق دون وعي وبلا ضوابط. لذلك كانت العلاقة الزوجية تعبيرا عن كونها سنة من سنن الحياة، تقوم بين ذكر وأنثى كطرفين متعاقدين، بكل ما يعنيه التعاقد من دلالات التشارك في رعاية هذه العلاقة.
ولا يمكن لمفهومي التعاقد والتشارك أن يقوما إلا بناء على فهم مخصوص غير قابل لتأويلات خارجة عن سياق رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط، الذي يعبر عنه شرعا وقانونا بالإيجاب والقبول. وإذا كان من فهم سوي للعلاقة الزوجية التي يراد لها حقيقة أن تبنى على التفاهم والانسجام، والتي يراهن على مساهمتها في استقرار العلاقات الأسرية المترتبة عنها، فهو لا يخرج عن مدار الوقوف الجدي على مدى تحقيق وتجسيد شروط إنجاحها على أساس رضا الطرفين المتعاقدين. وغير ذلك من الاجتهادات الاشتراطية لا يمكن إدخالها سوى في باب الضوابط التكميلية، إن كان لا مناص منها، بما لا يهدم مقومات وأسس مفهومي التعاقد والتشارك بين الطرفين.
وعلى هذا الأساس، فاختزال العلاقة الزوجية في بعد المنفعة الجنسية وتكريس عقدة التفوق الذكوري ودونية المرأة ما هو إلا انحراف بهذه العلاقة عن جادة التعريف الدقيق والصائب لها، بفعل العديد من الاشتراطات المكرسة لذلك التمييز السلبي ضد المرأة كطرف متعاقد ومشارك في هذه العلاقة. وهو ما سمح بالخروج عن الفهم السليم، عبر ترتيب العديد من الأركان والشروط غير المعقولة ولا الواضحة ولا الشفافة فيما يمكن تبريره من تقويض أسس المساواة في الحق في الاختيار وترتيب الحقوق والواجبات داخل بيت الزوجية وفي إطار العلاقات الأسرية. إذ أن العلاقة الزوجية لا هي بعقد يفيد المتعة قصدا، ولا هي ملك للذات في حق الاستمتاع، ولا هي ملك للانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن، ولا هي عقد مقصور على ضمان ملك الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا هي عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية، ولا هي عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع، ولا هي كما تصورته وطبقته مختلف المذاهب الفقهية على أرض الواقع منذ زمان، لما في ذلك من تشييء وتبضيع لأحد طرفي هذا التعاقد والتشارك، الذي هو المرأة طبعا.
وهذا الفهم البشري الذي تم إسقاطه على مفهومي التعاقد والتشارك في العلاقة الزوجية باسم القواعد والضوابط الدينية والشرعية، هو الذي أدى إلى جعل المرأة معقودا عليها في الزواج، وهو الذي رتب حكم عدم أحقية المرأة في مطالبتها الزوج بالوطء؛ على اعتبار أنه حق للرجل دون المرأة، والحال أنه عقد ينبني على المنفعتين معا. فإطار هذا الفهم المتخلف للزواج والمنحرف عن قواعد وضوابط مفهوم التعاقد والتشارك، هو الذي يجعلنا نعتبر أن الهدف من قوانين الأسرة في البلدان الإسلامية ليس دينيا ولا شرعيا، بقدر ما هو دعم وتعزيز للأسس الاجتماعية التي تعيش عليها هذه البلدان. وعليه، فالتعديلات المزمع إدخالها على هذه القوانين ينبغي لها أن تكون متجاوزة لذلك الفهم المتخلف للعلاقة الزوجية السائد في الموروث الثقافي، والذي انعكس في وقت سابق على تعريفات الفقهاء، والذي يريد تأبيده غير المواكبين للتطوارت والتغيرات الحاصلة في المجتمعات والعقليات المعاصرة. والأجدر بنا اليوم العمل على ألا يحافظ هذا الفهم على تجلياته في صياغة تعريف للزواج، وعلى تمظهراته فيما يليه من فصول ومواد منظمة ومفصلة لجزئيات هذه العلاقة على مستوى تحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ضمانا للحفاظ على جوهره المتمثل في كونه ميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة على قاعدة المساواة والإنصاف.
فإسناد حق التعاقد إلى المرأة لا يعني سوى التنصيص على حقها في مباشرة عقد الزواج، بنفس الصلاحيات والشروط المنصوص عليها بالنسبة للرجل؛ أي بشكل متساو. كما يدل على وجوب التنصيص على عدم التمييز في مجال القيام بالأعباء، إلا ما كان من استثناءات تقتضيها ظروف عدم تمكين المرأة اقتصاديا وتنمويا وتاريخيا وثقافيا، مراعاة لتأخر مؤسسات الدولة في ضمان الحقوق والحريات والرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة. لأن ضمان شروط ولوج العلاقة الزوجية من باب هذا الفهم التعاقدي والتشاركي يساهم بقدر كبير في الإجابة عن العديد من المشاكل التي تشكل مقدمات الإخلال بمفهوم الاستقرار الأسري، من حيث الحرص على خلق شروط التفاهم والانسجام بين الطرفين المتعاقدين، وتبادل التقدير والاحترام بينهما، والإعلاء من قيمة المودة وصيانة الأسرة والحرص على سلامتها وأمنها وطمأنينتها، بما يقوم بين المرأة والرجل من حسن معاشرة. ومن هنا نكون قد تجاوزنا النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها علاقة جنس واستمتاع، وأدرجنا باقي مكوناتها كتوابع ومترتبات عن هذه العلاقة داخل الفضاء الأسري العام. لأنها في الأصل تشكل بوابة لإقامة أسرة وحفظها ورعايتها وتقوية وشائجها.
ومن منطلق الحرص على المبدأ العام في التشريع، المتمثل في إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده، نعتبر أن النهي عن قهر المرأة وظلمها يستلزم إصدار نصوص قانونية حمائية تجعل منها طرفا مشاركا في المسؤولية الزوجية والأسرية. ومن منطلق البحث عن تحقيق مصالح الناس المتغيرة بتغير الشروط والأحوال، نعتبر أن مصالح المرأة، والتي هي مصالح مشتركة بينها وبين الرجل والأولاد داخل الأسرة، تكمن في ضمان حقوقها كاملة غير منقوصة، وبشكل متساو مع الرجل. ومن منطلق رفع المشقة والحرج على المكلفين في الفعل والترك، فإن النهوض بأوضاع المرأة داخل العلاقة الزوجية يعد من صميم رفع المشقة والحرج، لئلا تصطدم المصالح المجتمعية المتغيرة والمتجددة باستمرار بالنصوص التشريعية، ولئلا يحسب هذا الاصطدام على المرجعية الدينية ذاتها، بدلا من احتسابها على المتقاعسين في بذل الجهد واستفراغ الطاقة والبحث والاجتهاد لإيجاد حلول ملائمة وفق منظور مقاصدي عام. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهو ما يدعم رعاية الزوجين لهذه العلاقة على قدر المساواة فيما بينهما، وفق منطق التسيير والتدبير التشاركي. ويكفي اعتبار ذلك فهما متجددا للواقع والنصوص للمساهمة في تطوير البناء الأسري والمجتمعي، دون التنغيص على الاجتهاد والنقاش والتداول بين الناس بسيف تعطيل النصوص الشرعية. فما كان لهذا السيف بكل قوته وحدته أن يقف في وجه تعطيل نصوص عتق الرقبة وما ملكت الأيمان ولا إسقاط الولاء وبيت المال من عقد الإراثة ولا إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم ولا تعطيل حد السرقة والزنى، بقدر ما كان كل ذلك تعبيرا عما حققته الإنسانية من قفزة نوعية وهائلة بقضائها على العبودية والنخاسة والحط من كرامة الإنسان، بإعلاء شأن وقيمة الاجتهاد بناء على المصلحة المجتمعية والمقاصد التشريعية العامة.
وكذلك هو أمر القوامة، الذي أجاز به الفقهاء في وقت من الأوقات تكليف الرجال بأمور النساء وشؤونهن في سياق مفهوم الرعاية الأحادي الجانب، بناء على تأويل وتوظيف نصوص شرعية، والذي تضغط به اليوم القوى المحافظة لتكريس مفهوم الأسرة الذكورية ولعرقلة المحاولات الهادفة إلى التطوير والتغيير. والحال أن مفهومي الحفظ والائتمان اللذان يدخلان في صميم رعاية العلاقة الزوجية والأسرية، ومفهوم المسؤولية بما تعنيه من مطالبة بالقيام بالمهام والالتزامات، كل ذلك ينبغي أن يحمل على تكليف الزوجة والزوج، كحافظين للأسرة ومؤتمنين عليها ومسؤولين عن شؤونها ومكلفين بكل ما يتعلق بها، بما منحهما الله من عقل وقدرة على التدبير وخصهما به من كسب وإنفاق كما هو الحال في عصرنا هذا. وهو الفهم الذي يتعارض مع مفهوم القوامة كما ترسخ في عقلية الفقهاء بفعل التفكير في تنويع أساليب الخضوع للطاعة والتأديب التي مارسها الزوج على الزوجة من هجر وعدم إنفاق وضرب وتنكيل وحرمان من زيارة الأهل واستزارتهم، وبفعل الحرص على تأكيد إلزام المرأة بالإحصان والعفاف، وغير ذلك من التصرفات المشينة والمهينة والحاطة من الكرامة.
فحري بنا الإشارة إلى أن العلاقة الزوجية هي جزء من نظام اجتماعي يتغير بتغير شروطه وظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي فهي تعرف اليوم تحولات عميقة ترخي بظلالها على حياة الأفراد؛ من حيث التراجع في المستوى المعيشي والعجز عن توفير تكاليف الحياة المرتفعة وتعاظم المطالب المادية، مما يدفع بالناس إلى الهروب من الحياة الزوجية أو الاضطرار إلى التقصير في القيام بالمسؤوليات الأسرية أو الوصول إلى نفق حل عقد الشراكة وإنهاء العلاقة الزوجية والتخلص من تبعاتها.
ومن باب ضرورة البحث عن حل النزاعات والمشاكل القائمة داخل العلاقات الزوجية، ومن ناحية أهمية ربط هذه العلاقة بنوعية النظام الاجتماعي الذي تنتظم في إطاره، على المشتغلين بهذا المجال سواء من جانب التنظير أو التشريع إدراك أسباب زعزعة استقرار هذه العلاقة التي تعددت بفعل تعدد وتنوع العوامل المرتبطة بالتحولات الجارية اليوم. إذ أن القضية لا ترتبط فقط بالأفراد من حيث نموهم الحركي والحسي والعاطفي والعقلي، ولا فقط بما تلقاه كل منهم من تكوين في إطار التنشئة الاجتماعية والتربية القيمية والتكوين المعرفي والعلمي، بل هي شديدة الصلة بأوضاعهم المادية التي أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول "تواضع" دخل الأسرة فيما يخص عجزه عن تلبية الاحتياجات، وإلزام الأزواج وحدهم بالنفقة دون الزوجات، وتقتير البعض وتقشفه في الإنفاق على الزوجة والأولاد.. بل تذهب الأمور إلى حد بروز ظواهر كثيرة متعلقة بارتفاع تكاليف الزواج، والخوف من السقوط في الفقر والعوز، والضوائق المالية التي أصبحت تعرفها العديد من الأسر، وتوجه الرجال نحو الاقتران بنساء ذوات مال أو وظائف للتغلب على مصاعب الحياة.. وهو ما أفرز حرص بعض الزوجات على حماية أملاكهن من اعتداءات أزواجهن في أوساط بعض الفئات الاجتماعية، وإلى ظهور الكثير من المشاكل ذات الصلة بظروف السكن غير الملائمة في أوساط فئات أخرى؛ كالاكتظاظ والتكدس وعدم توفير سبل الراحة الزوجية والتربوية، وتكاثر أسباب رفض الزوجات للسكن مع أبوي الزوج...
وهو الوضع الذي أدى إلى نوع من الجموح الطائش حين امتد إلى وجود الكثير من المشاكل المرتبطة ببلوغ بعض الأزواج أرذل العمر مع زوجات في مقتبل عمرهن، وبالتصرف في أموال اليتامى، وبرغبة الأزواج في التعدد التي لم تعد محصورة في الميسورين ماديا بل تعدتهم إلى المستضعفين من عموم الناس الذين لا يقوون حتى على إنجاح العلاقة الواحدة، وبالتحايل على الشرع والقانون بالسرية والتكتم في الإقدام على التعدد بواسطة قراءة الفاتحة، وبتزايد المشاكل الناجمة عن ظاهرة الخيانة الزوجية في ظل عدم استقرار العلاقات الزوجية. دون التغاضي طبعا عن سوء الخلق وقبح المعاشرة في ظل اهتزاز المنظومة القيمية، ومعاناة الزوجات من مجون بعض الأزواج وتفرغهم لأمور هادمة للاستقرار الأسري، وإنكار الأزواج للأولاد ولحمل زوجاتهم، وتشهير الزوجين ببعضهما البعض والتطاول على بعضهما باللسان على مرأى ومسمع من الأولاد وبين الأهل والجيران، وغياب الأزواج عن الأسرة للعمل أو التجارة أو الإهمال، والاغتصاب الزوجي الذي تكاثر حضوره في العلاقات الزوجية، والحرمان من الاختيار والتكافؤ والرغبة عند عقد القران، والإمعان في حجز الزوجات والمبالغة في حجبهن وتدجينهن داخل البيوت، وكره الأزواج صغار السن وعديمي الدخل لزوجاتهم بسبب الإكراه والإجبار على الزواج، وعدم الرغبة في إنجاب الأولاد أو الإكثار منه، ومنع المرأة من العمل والتكسب من أجل سد الخصاص المادي، وامتناع الزوجات عن خدمة آباء وأمهات الأزواج ...
ونظرا لتعدد وتنوع هذه العوامل وغيرها، وما تنتجه من مشاكل زوجية تلقي بالأفراد في بحر من اليأس والقنوط من العلاقات الزوجية بصفة خاصة وأوضاعهم الاجتماعية بصفة عامة، لم تعد الزوجات ولا الأزواج في الكثير من الحالات على استعداد للسمو والارتقاء الأخلاقي والاتصاف بسعة الصدر وعظيم الحلم وجميل الصبر وبليغ العفو. وبدل تملك الغضب والصبر على السوء وعدم الانجرار إلى التوتر، أخذت ردود أفعال الزوجين تتسم باللجوء إلى السلوك اللفظي المشين مثل التناوش الكلامي والتلاسن، واتخاذ الأزواج لوسائل زجرية أو تأديبية كالخصام والتأنيب والهجر واجتناب الأكل أو التضييق، وتعنيف الزوجات عن طريق الإهانة والضرب المبرح، وعصيان الزوجات لأوامر الأزواج والرغبة عن فراشهم والاستخفاف برجولتهم والإمعان في إهانتهم، وبالتالي اللجوء إلى طلب التطليق، وقد تشكل إقامة علاقات غير شرعية خارج نطاق الزوجية سلوكا انتقاميا أو متنفسا في العديد من الحالات.
فما عاد الفهم التقليدي للزواج الذي كان معتبرا في وقت من الأوقات، والذي لا يعير اهتماما اليوم لهذه العوامل ولا للاجتهاد من أجل تجاوز أوضاع العلاقة الزوجية، يسعف في تدبير العلاقة الزوجية في هذا العصر، بالنظر إلى الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية والقيمية المتحولة والمتغيرة بشكل متسارع، وهو ما أصبح يفرض الوقوف في وجه الضغوط التي تمارسها القوى المحافظة داخل المجتمعات الإسلامية. وبقدر ما تقتضي الضرورة اليوم إسناد حق التعاقد إلى المرأة مثلها في ذلك مثل الرجل، والتنصيص على حقها في مباشرة عقد الزواج، وحصولها قانونيا على نفس الصلاحيات والشروط المنصوص عليها بالنسبة للرجل، يلزم دعم العلاقة الزوجية والأسرية من طرف مؤسسات الدولة بالعديد الإجراءات والتدابير المرتبطة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية للأفراد داخل المجتمعات، لتمكينهم من القيام بالأعباء والمسؤوليات المادية والمعنوية والحصول على مقومات الاستقرار الأسري. إذ لا محيد عن توفير الشغل للمواطنات والمواطنين وانتظامه، وضمان استقرارهم فيه بشروط تكفل كرامة العيش بين أقاربهم. ولا مهرب من تمكينهم من حماية اجتماعية قادرة على توفير شروط الاطمئنان لديهم فيما يخص القدرة على امتلاك سكن لائق وتغطية صحية جيدة ونظام تعليمي وتربوي في مستوى طموح الارتقاء بالعلاقات الزوجية والأسرية وبأوضاعها المادية والتربوية، التي ينبغي أن تكون مُسهمة في المجهود التنموي الوطني الشامل والمستدام داخل هذه البلدان.
وبهذا المنظور يمكننا ولوج عالم الاجتهاد من أبوابه الشاسعة وفق مقاصد تشريعية مساهمة في تحيين القواعد القانونية ومساطر أجرأتها، بإدراك واع لصعوبة هذه المهمة التي لا تعفينا من مسؤولية مباشرة القيام بالواجب، في إطار تغيير الفكرة المتجذرة حول النساء ككائنات دونية. وهو ما يقتضي نفسا عميقا واجتهادا رصينا واقتراحات عملية دقيقة ودالة وواضحة، لضمان مساواة بين البشر وعدل في تقدير ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.