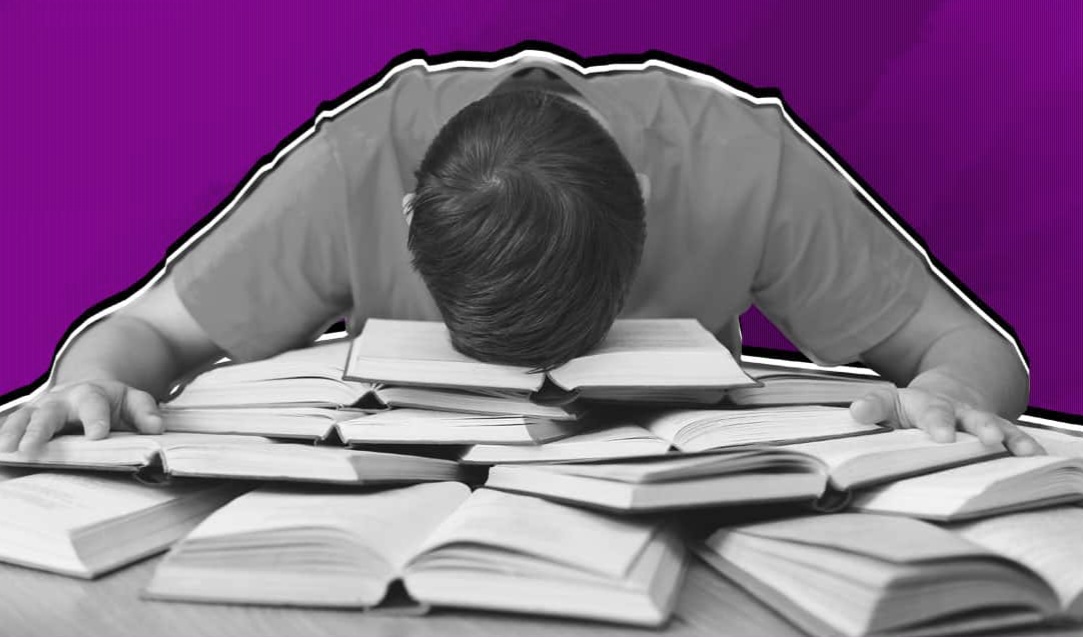الكل يستنكر الفساد، والكل مقتنع ومدرك أن سبب التردي العام الذي نعيشه سياسيا واجتماعيا وتربويا ومؤسساتيا... سببه الفساد أولا وأخيرا... إلا أننا حينما نحلل هذا الفساد نركز على مظاهره فقط دون أن نبحث عن ميكانيزمات اشتغاله أو عن جذوره العميقة وأسباب استمراره واستشرائه في واقعنا الاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي والصحي...
إن هذا الفساد الذي نشتكي منه ونئن تحت وطأته منذ الاستقلال يشتغل في بيئتنا وفق ثلاث آليات بنيوية متماسكة هي: آلية القابلية للفساد، وآلية التطبيع مع الفساد، وآلية إنتاج الفساد وإعادة إنتاجه. وسنقف اليوم مع الآلية الأولى لهذه البنية ألا وهي آلية القابلية للفساد.
1 – آلية القابلية للفساد:
إن نسبة معتبرة من أفراد مجتمعنا لديها قابلية لممارسة الفساد والإفساد، لأنها تتعلم ذلك وتتربى عليه منذ المراحل الأولى من عمرها، وذلك من خلال عدة وسائل وممارسات منها:
الخطاب التداولي حول الفساد والإفساد، حيث يحبل هذا الخطاب بأمثال سائرة ومقولات جاهزة من قبيل: (لقيتي ما ضرب ضرب – ضرب الحديد ماحدو سخون – جاتك الهمزة ما تزكلهاش – ما تكونش نية في الخدمة –كون مطوّر وعايق –عندك إحرثو بيك بحال الحمار – دهن السير يسير...)، وكلها عبارات تصب في اتجاه التشجيع على الغش في المعاملات الخاصة والعامة، والتقاعس عن أداء الواجبات بالكفاءة المتطلبة، وانتهاز الفرص ولو كانت دنيئة وغير قانونية، وامتداح السلوكيات الشاذة في التعامل واعتبارها ضربا من "الذكاء" الذي تنال به أقصى الغايات وأعلى المراتب !!!
تصرفات تصدر من الأطفال الصغار وتبدو "بسيطة" ولكنها تحمل في طياتها الجينات الجنينية للفساد، لأنها تتطور وتنمو من "البسيط" إلى المعقد ومن "الخفيف" إلى الثقيل مع توالي عمر "المفسد الصغير" الذي استأنس واسلتذّ بأول خطوة في عالم الفساد دون منكر ولا نكير (مثال: طفل صغير في المدرسة يأخذ قلم زميله في الفصل الدراسي بنية الاستيلاء والإخفاء، أو حتى عن طريق الخطأ، وحين يخبر والديه تتم تزكية تصرفه مع التأكيد على الحرص على الممتلكات الخاصة (عندك يديروها بيك) !!)
القبول بانتهاك حرمة الممتلكات العامة (حافلات النقل العمومي (BUS) – حاويات الأزبال – مدارس – حدائق – مرافق صحية – ملاعب رياضية – مكاتب إدارية – علامات تشوير الطرقات – أعمدة الإنارة...) بكل أشكال الفساد والإفساد (سطو – تخريب – إحراق – تعطيل – إتلاف ...)، وإن كان لها صميم اتصال بعموم المواطنين أو فيها مصلحة ظاهرة وراجحة للفئات الأكثر احتياجا لتلك الممتلكات أو الخدمات العامة... ويتم تسويغ هذا الاعتداء الشنيع على تلك الممتلكات بدعوى "الانتقام" من جهاز الدولة !! وكأن هذه الدولة جهاز هلامي لا يمت بصلة إلى هؤلاء المفسدين "الصغار" !! أو بدعوى "الانتقام" من المسؤولين الكبار !! وكأن هذه الممتلكات مسجلة ومحفظة في اسم هؤلاء المسؤولين، مع أن الممتلكات الخاصة والحقيقية لهؤلاء المسؤولين الكبار لا تتعرض لأي سوء ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها. وهنا يلتبس الأمر على هؤلاء المفسدين "الصغار"، حيث يمارسون فسادا في حق أنفسهم ومصالحهم وممتلكاتهم العامة بشعارات مخلوطة ومغلوطة، بل ويتم –أحيانا- تبرير مثل هذه السلوكيات المدمرة على أنها "نضال ضد الفساد والمفسدين" !!
وهكذا تتقوى القابلية للفساد نفسيا وتربويا واجتماعيا، فتتحول مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال إلى ظاهرة جمعية تحمل في طياتها كل المتناقضات فهي خفية وظاهرة، وهي ممنوعة ومشروعة، وهي مستهجنة ومألوفة وهي مرفوضة ومرغوبة !! الشيء الذي يجعلها تتحول إلى توظيف آلية أخرى لمزيد من الفساد والإفساد، هي آلية التطبيع.
2 – آلية التطبيع مع الفساد:
يظهر التطبيع مع الفساد من خلال التعايش معه وتداول أخباره لدى العامة والخاصة في المقاهي وفي الإدارات وداخل الأسر وفي المؤسسات الرسمية التي تسهر على التشريع أو التنفيذ أو حتى تلك التي تسهر على إنفاذ القوانين وزجر المخالفين... ويتداول الجميع تقارير مؤسسات التدقيق في كيفية تدبير المال العام كالمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، وتقام لجان لافتحاص كيت وكيت مؤسسة أو التحقيق في كيت وكيت قضية... لكن الأمر كله يبقى في حدود الكلام والتداول السلبي لأخبار المفسدين و"مغانمهم" التي "غنموها" في أوقات قياسية.. دون أن يتحول القول السلبي إلى فعل إيجابي يقمع الفساد والمفسدين... إلا في حالات نادرة جدا!!
ويوظف الفساد عدة واجهات لتكريس هذا التطبيع واستدامته في المجتمع ومنها:
واجهة المؤسسات الحزبية والنقابية، حيث تتم تزكية الفاسدين والمفسدين من خلال التمكين لهم في بنية الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، سواء في مواقع المسؤولية (عضوية الأمانة العامة – رئاسة المجالس الوطنية – الهيئات الموازية...) والتمثيلية البرلمانية في غرفتي البرلمان بل وحتى في جهاز الحكومة بالاستوزار تحت المظلة الحزبية أو النقابية... الشيء الذي جعل عموم المغاربة ينظرون إلى هذه الأحزاب والنقابات على أنها "أكبر مشتل لصناعة الفساد ورعايته" بدل أن تكون مؤسسات حاضنة للمواطنين وتأطيرهم بالقيم الإيجابية التي تبني الوطن وتحفظ كرامة المواطن.
واجهة الإعلام، حيث يصر المفسدون على الظهور في كل المنابر الإعلامية والحديث عن قضايا مصيرية تهم المواطن ومنها "التصدي للفساد والمفسدين"!! واستئجار أقلام صحفية وإنشاء مقاولات صحفية لتلميع صورتهم وفرضها على الجمهور...
واجهة الأعمال الخيرية والإحسانية، حيث يعمد الفاسدون إلى ما "تبييض" ثرواتهم الفاسدة بالمساهمة وبسخاء في تمويل بعض الأنشطة الخيرية التي تخص الفئات المعوزة في البوادي أو في الأحياء الهامشية للمدن، أو في بناء المساجد وتمويل حملات إفطار الصائمين وإرسال الحجاج والمعتمرين على نفقاتهم الخاصة... مع العلم أن القاصي والداني يعرف أن مصادر ثروة هؤلاء هي الفساد ابتداء وانتهاء !!
واجهة الجمهور العام، حيث يتم الإعلاء من شأن المفسدين والتمكين لهم اجتماعيا من خلال النظر إليهم من طرف الجمهور على أنهم يمثلون "نماذج للنجاح المادي" و"الرقي الاجتماعي"، والتقرب إليهم والسعي الحثيث من طرف عموم الناس لنيل "شرف التعرف عليهم"، و"قضاء الحوائج على أيديهم" لأنهم (واصلين – في يدهم – واعرين – كبار بزاف – قادّين – كيقضو الغراض - كياكلو ويوكلو – يعوّل عليهم...) وهلمّ جرا من العبارات التي تجعل هذه النماذج تكون في محل ثناء وحظوة وإعلاء... بدل أن تكون موضع قدح وازدراء وإسفاف... بل ويزداد الأمر تطبيعا مع هؤلاء حينما يتطلع الكثيرين ممن حولهم إلى الاستفادة من "بركاتهم" ولم لا بلوغ "مقاماتهم" واكتناز ما يكتنزون من الجاه والمال على طريقتهم ونهجهم... وكأن لسان حالهم يقول مثل ما قال المفتونون بقارون –رمز الفساد المالي-: {قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم}. مما يزيد المفسدين اطمئنانا ذاتيا، وجرأة على توسيع دوائر نهبهم، ووهجها وقبولا اجتماعيا!!
وهكذا يعيش المجتمع حالة فُصام نكد تجاه الفساد؛ فهو يرفضه أخلاقيا وشعاراتيا، لكنه يتطبع معه يوميا ويُمارِسه أو يُمارَس عليه في شكل خدمات مؤسساتية ومنافع اقتصادية واجتماعية، ويقويه بشخصيات وجهائية ظاهرها الصلاح وباطنها الفساد والإفساد!!
3 – آلية إنتاج الفساد وإعادة إنتاجه:
بدهي جدا أن تكون النتيجة الحتمية للطورين الأولين من بنية الفساد-أي القابلية والتطبيع- هي إنتاج الفساد وإعادة إنتاجه، بحكم أن البيئة الاجتماعية والتربوية والسياسية مهيأة لهذا المنتوج وتنميته، لأن كل الآليات الراصدة للفساد أو المتعقبة لآثاره أو الزاجرة لارتكابه معطلة أو شبه معطلة من طرف المفسدين الكبار والصغار على حد سواء؛ فالكل يسعى إلى إنتاج الفساد الذي يليق بحجمه ومكانته، فمنهم من ينتجه في حجم بيضة أو ما دونها، ومنهم من يبلغ به حجم الفيل أو الدينصور.. والنتيجة أنه فساد في فساد مهما كبر أم صغر... لأن الكل ينتمي إلى منظومة الفساد البنيوي الذي استشرى في المجتمع.
ويظهر إنتاج الفساد وإعادة إنتاجه على مستويين:
المستوى البشري، حيث يتم إنتاج الفساد واستدامته من طرف الأجيال المتعاقبة منذ فترة الاستقلال إلى يومنا هذا، وكأنه "إرث حضاري مشترك لا ينبغي التفريط فيه"، إذ يعيش المواطن، بغض النظر عن جنسه (رجل – امرأة – شاب – شيخ...) أو مركزه الاجتماعي (فلاح – طبيب- معلم – إمام – وزير – مهندس- طالب...) أو مستواه التعليمي (أمي – ابتدائي – ثانوي – جامعي)، حالة غريبة من الرغبة في إنتاج الفساد، بل والقدرة على ممارسته بجميع تمظهراته (استغلال – غش – نصب – احتيال – تقصير ...)؛ ويزداد الأمر سوءا لدى النخبة المتعلمة، ولا أقول المثقفة، التي كانت تتهم "أجيال الأمية أو شبه الأمية" بإنتاج الفساد أو التواطؤ على ممارسته !! ومنها من كان إلى عهد قريب، وقبل التمكين له في موقع من المواقع العامة أو الخاصة، يستنكر الفساد "ويناضل ضده" ويتوعد بمحاربته والحد من آثاره !!
المستوى القانوني، حيث إن النخبة المتعلمة الفاسدة، ومن يدور في فلكها من الفئة التابعة، لم تعد تمارس الفساد بشكل "عشوائي" أو "اعتباطي" أو بدون غطاء، بل تمارسه باسم القانون !! فهي تتحرك تحت مظلة القانون وتستنزف الثروات باسم القانون (الغش في الصفقات العمومية مثلا)، وتستفيد من امتيازات عينية ومالية باسم القانون (تنقلات – تعويضات – تقاعد برلمانيين – تقاعد وزراء – أراضي ... رغم أن هذه الامتيازات صيغت وأنتجت على مقاس الأحزاب الإدارية التي كانت تتولى إدارة الشأن العام في أغلب المواقع منذ الاستقلال وحتى أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات.. وتستنزف المال العام بشكل فظيع...)، وتتمتع بالريع النقابي والحزبي تحت غطاء القانون (التفرغ – سفريات – ملتقيات...)، وتتولى مناصب المسؤولية بالقانون (التعيين في مناصب المسؤولية العليا بدون كفاءة علمية أو مهنية...) وهكذا أصبح القانون، بشكله لا بجوهره، أداة لإنتاج الفساد وتوفير الحصانة والنفوذ لممارسة ما يسميه الاقتصادي الفرنسي فريدريك باستيا بـ"النهب القانوني" (Spoliation légale) حيث تمتلك هذه الفئة آليات شرعنة فسادها وتحصين مصالحها وتأويل جميع ممارساتها والإفلات حتى من المحاسبة والمتابعة باسم القانون!!.
مما يجعلنا نتساءل، ويتساءل معنا كل من له مُسْحة عقل وضمير، هل أصبح هذا القانون خادما للفساد بدل أن يكون كابحا لها، ومصدرا للشر بدل أن يكون مصدرا للخير، ومكرسا للظلم بدل أن يكون ناشرا للعدل، ومعيقا للتنمية بدل أن يكون دافعا لها، وسالبا للحقوق بدل أن يكون ضامنا لها؟ وحينما يبلغ الفساد هذا المستوى من التنظيم باسم القانون، ويخدم مصالح الفئات التي تصنعه، فإن كل الفئات المنهوبة ستحاول الدخول بشكل منظم في منظومته، وبالتالي يصبح "الفساد في نظر الكثيرين عادلا ومقدسا".
مقترحات للعلاج؟
- بناء الفرد المواطن في جميع أبعاده، كإنسان ووعي ومسؤولية ومشاركة وتفاعل إيجابي... لأن منطلق التغيير ومنتهاه يبدأ من الفرد وينتهي إليه.
- تنقية قاموسنا التداولي ومناهجنا التربوية وسلوكياتنا الاجتماعية من كل مظاهر القابلية للفساد والإفساد.
- الاحتجاج على الفساد مهما كان حجمه كبيرا أم "صغيرا" فمعظم النار من مستصغر الشرر.
- الارتقاء بالممتلكات العامة إلى مقام المقدسات الوطنية وصيانة حرمتها من العبث والتطاول والتخريب...
- رقمنة الحياة العامة وجميع خدماتها، للحد من العلاقات المباشرة بين الأفراد أثناء القيام بخدمات أو طلبها، لأن أساس الفساد إنتاجا واستهلاكا هو سلوك بشري محض.
- محاصرة الفاسدين والمفسدين وعدم التطبيع معهم اجتماعيا وقانونيا ومؤسساتيا.
- تفعيل المحاسبة الأدبية والزجرية في حق المفسدين مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية أو الجهوية أو القبلية أو العائلية...، وأن تكون العقوبات في حقهم من جنس الأعمال التي اقترفوها في فسادهم (سرقة المال العام = التجريد من جميع الممتلكات الخاصة – استغلال النفوذ = التجريد من المسؤوليات – استغلال المنصب أو الوظيفة لأغراض شخصية= العزل من الوظيفة – إفساد البضائع = الاقصاء من الأسواق التجارية – إفساد صحة المواطنين= التطبيب مجانا لمدة معينة...) وهكذا دواليك لأن العقوبات الحبسية وحدها لا يمكن أن تردع الفاسدين ولا أن تؤثر في مسار حياتهم أو حتى في الحد من فسادهم وإفسادهم.