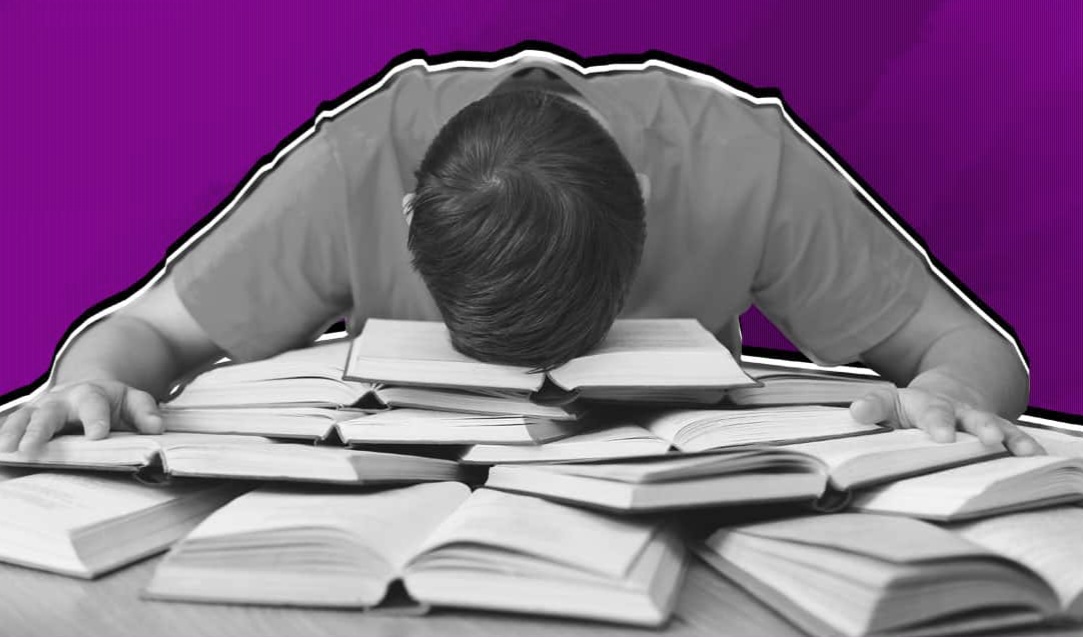لطالما انتقدنا الكنيسة وسخرنا من ممارسات الرهبان في العصور المظلمة بجعلهم الدين أصلا تجاريا يبيض ذهبا، ببيع صكوك الغفران بأثمنة خيالية بحسب نوعية المعصية.
ولطالما رميناهم بجريرة أكل أموال الناس بالباطل. فما الفرق بين هذا الذي كان محط سخريتنا، وبين ما بتنا نعيشه عيانا بيانا، إذ أصبحت لنا دكاكين للرقية تتناسل كالفطر، تنافس العيادات الطبية المتخصصة. لا يقتصر أصحابها على لهف أموال الناس بالباطل، بل تجاوزوها لما هو أخطر، باستغلال النساء والفتيات جنسيا واغتصابهن، وتصويرهن في أوضاع جنسية لابتزازهن. كل ذلك تحت عباءة الدين، مما يغشي أبصار ضحاياهن ويعطل عقولهن، إلى أن تقع الكوارث وتصبح المصائب بـ"جلاجل"، على حد تعبير إخواننا الشماليين.
فهل في مصلحة هؤلاء الانتهازيين أن ينتشر الوعي بين عامة الناس بجوهر الدين الذي لا علاقة له بمظاهر الشعوذة هاته على أيدي هؤلاء المرتزقة؟ إنهم يسعون بكل الوسائل إلى تكريس التخلف الفكري، ليبقى المواطنون حبيسي معتقداتهم الفاسدة بتفسير كل ما يصيبهم بالجن أو العين أو السحر. ومن ثم، تبقى دكاكينهم ملاذهم الأساس، حيث يمارسون عليهم طقوسهم الموغلة في التخلف وامتصاص جيوبهم كأية حشرة لما تتسلط على جرح عفن.
الغريب هو أنه إذا كانت ممارسات القساوسة تنحصر في أمور الناس الأخروية، فإن تجارنا بالدين والمستأكلين به تجاوزوهم بكثير؛ فقد نصبوا أنفسهم معالجين لكل الأمراض العضوية منها والنفسية، حتى التي لا تزال مستعصية على البحث الطبي عالميا كأنواع السرطانات، وعلاج العقم وغيرها، وكذا ادعاء حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بأمور الزواج والطلاق، وزعم فتح أبواب الرزق لمن كسدت تجارته أو قل مدخوله، وإزالة "العكوس" للعزاب والعازبات، وتحسين العلاقة بين الرؤساء ومرؤوسيهم في العمل، وضمان الفوز الساحق في المباريات، وهلم جرا مما يعيشه الناس من أزمات ونكبات.
يؤثثون أماكن جرائمهم بكل وسائل التخدير كتلاوة القرآن والأبخرة والعطور المكية لما لها من تأثير في عقول الناس، وبإظهار الزهد؛ وذلك بادعاء أن ما يقومون به إنما لوجه الله لا يبغون من ورائه جزاء ولا شكورا.
وأبشع مما سبق وأحقر، لما ينتزع بعض الانتهازيين الدين من سياقه المرتبط بالقيم السامية لا مجال فيه لأية مزايدة، إلى استعماله مطية لنيل مكاسب سياسية، متفوقين على ميكيافلي في أنانيته، بما أنه أقصر السبل وأبسطها إلى نفوس الناخبين وانتزاع أصواتهم. فتجدهم لا يملون من تكرار أسطوانتهم المشروخة بأنهم ما ولجوا مجال السياسة إلا من أجل تخليق السياسة وأسلمتها، بإيهام الناس أنهم سيوف الله المسلولة في مواجهة جحافل المارقين من العلمانيين. ومنهم من يقسم بأغلظ الإيمان وقد ينتحب، أنهم ما اقتحموا عقبة السياسة إلا لإصلاح أوضاع الناس المزرية وليس لدنيا يصيبونها أو امرأة ينكحونها بلغة الحديث النبوي. فلم لا ترك الدين موقرا، بدل استغلاله في مجال السياسة من باب إقحام المقدس في المدنس، والتقدم إلى المواطنين ببرامج واقعية وبمشاريع مضبوطة بميزانيات دقيقة، حتى إذا حان موعد المحطات الانتخابية، يسهل معرفة ما تحقق على أرض الواقع وما لم يتحقق؟
أما الشعارات ودغدغة العواطف واستغفال البسطاء، فإنها لا تزيد الأوضاع إلا سوء ولا تزيد الناس إلا نفورا ربما حتى من الدين نفسه. فليس كل الناس في مستوى التمييز بين الدين والتدين والممارسات الشخصية للانتهازيين والوصوليين.
نوع آخر من الاتجار بالدين، تكفي جولة في الأسواق والمتاجر، لتلفت نظرك أشكال الباعة البرانية، فجلهم يطلقون اللحى والسواك والقمصان القصيرة، بما أنها وسائل فعالة للتأثير في المشترين. ففي مخيال العامة أنها دليل على صفاء السريرة وصدق المعاملة. والمحظوظ منهم من يرتسم الدرهم على جبينه، فيكتمل التعسف على الآية الكريمة "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" بادعاء الإيمان ومن تم استمالة الزبناء إلى متاجرهم.
ألم يحن الوقت، بعد، للقطع مع كل أشكال الاتجار بالدين والاستئكال به؟ الدين للجميع، فلا مجال لاحتكاره من طرف أية جهة، فردا كانت أو جماعة أو حزبا.