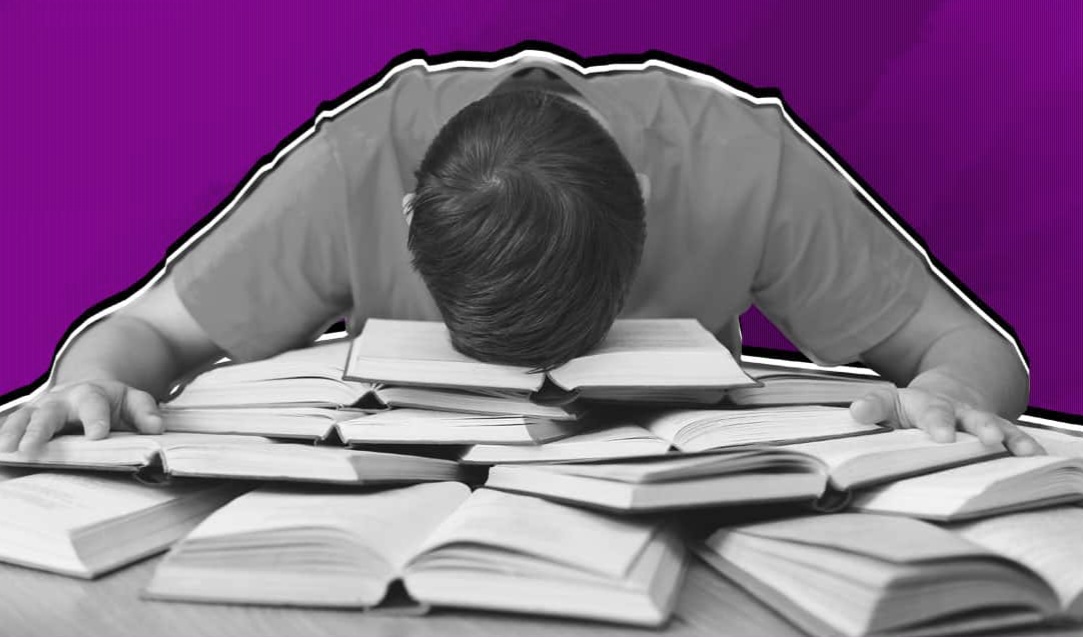لم يعد ممكنا الآن الانفلات من إسار الجيل الجديد من العولمة، خصوصا في دول الجنوب التي ترزح منذ عقود تحت نير مختلف الإكراهات والمشكلات المعيقة للتنمية، والاختلالات الاقتصادية، والأعطاب السياسية والفوارق الاجتماعية. لأن هذا الجزء من العالم، ومن بينه دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عاش أصلا تحت وطأة التبعية، بسبب عوامل تاريخية مرتبطة بالظاهرة الاستعمارية، وصاغ مفاهيمه السياسية والاقتصادية، وتصوراته وتمثلاته الثقافية، استنادا إلى مرجعيات المركز الصناعي والتكنولوجي الذي يشكل الغرب بؤرته ونواته الصلبة. واليوم، وبفعل التحولات الجذرية التي طاولت اليقينيات الإيديولوجية، والطروحات الاقتصادية، والشعارات السياسية، فقد صار من المستحيل المراهنة على اختياراتٍ أملتها الفترات السابقة، بكل أحلامها ومثلها وأساطيرها المؤسسة ليوتوبيا، سكنت ردحا من الزمن عقول أجيال بكاملها، ودغدغت مخيلتها الجماعية، انتصارات حركات التحرّر في أكثر من قارة، عندما كانت تحلم ببناء مجتمعاتٍ تسودها العدالة، وتستفيد من خيرات وثروات بلدانها التي كانت عرضة للنهب والاستغلال الفاحش، طوال عقود، من القوى الاستعمارية.
التحولات العميقة والثورات التي مست مختلف الأنساق والمنظومات، ومراهنة أغلب المجتمعات على الاقتصاد غير المادي، حيث أصبحت تواصلية بامتياز، في ظل السطوة غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي، وشبكات التواصل الاجتماعي، كلها عوامل تجعل من الاندماج في ركب ومسار الجيل الجديد من العولمة التكنولوجية، حتمية تاريخية، بغية تأمين موقع مريح ومتقدم في الفضاء الدولي، وتمكين المجتمعات النامية من تأهيل مقوماتها، وتمنيع بنيانها الاقتصادي ضد أي كارثة محتملة، أو أزمات فجائية يصعب التكهن بها، لا سيما في ظل اختلالات اجتماعية، أحدثتها سنوات طويلة من سوء تسيير وإدارة المال العمومي، والتوزيع غير العادل للثروات، غير أن الاندماج في نظام العولمة في تجلياتها الجديدة لا ينبغي أن يفضي بنا إلى مفهوم التفكك والتلاشي، وفقدان العناصر المشكلة للهوية والقيم المحدّدة لسلوكٍ اجتماعي، له امتداده التاريخي وعمقه الثقافي والحضاري، ما يطرح ضرورة اتخاذ سلسلة من التدابير الجوهرية والجريئة، لإيجاد شروط الإقلاع الشامل، والانتقال النوعي في شتى المجالات، بما في ذلك مجال البحث العلمي.
في مقدمة هذه الشروط إرساء (وترسيخ) هياكل دولة الحق والقانون، الضامنة والحاضنة
لانتشار واستقرار وتجذرالثقافة الديمقراطية والتعدّدية الفعلية، وحرية الفكر والتعبير والصحافة والمبادرة الخلاقة والمنتجة. وأيضا، عبر منح المجتمع فرص الرقي المادي والرمزي، من خلال تحسين أوضاعه المعيشية. وبموازاةٍ مع ذلك، تحصينه ضد آفة الأمية والجهل. وإذا لم يتم تفعيل مثل هذه الإجراءات، فإنه سيكون من العبث، تحقيق الانطلاقة الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق حزمةٍ من الأهداف. لأن حدّة المنافسة، ودكتاتورية المنظومات الاقتصادية العالمية، واحتكار المعلومات والوسائط الإعلامية من أقطاب تتقاطع وتلتقي في بوتقة المصالح المشتركة، هي بمثابة طاحونة لن ترحم أحدا، ولن تمهل بلدا لالتقاط أنفاسه، فالمصالح هنا تتحول إلى معيار وحيد يتحكّم في نسج العلاقات بين الصغار والكبار.
وإذا استحضرنا الكيفية التي تشتغل بها الآلة الاقتصادية العالمية، الموجهة من الشركات العابرة للقارات، والمؤسسات المالية الكبرى، سنفهم بسرعة سبب تعالي صرخات الاحتجاج على هذه العولمة، حتى في الدول التي حققت طفراتٍ وتراكماتٍ على جميع المستويات، كما هو الشأن في فرنسا التي تحولت فيها حركة السترات الصفراء إلى تعبير صارخ عن جيل جديد من المطالب، خصوصا في ظل انهيار مؤسسات الوساطة من نقابات وأحزاب سياسية. ومن هنا ندرك حجم القلق الذي أضحى يكتنف شرائح واسعة من المجموعة الدولية والمجتمعات، وكل هذه الأشكال الاحتجاجية التي تعبر عن قلق حاد إزاء رهاب أو شبح المجهول الاقتصادي والسياسي، تستمد مشروعيتها من هيمنة الأنانية المُفرطة والجشع الزائد عن اللزوم اللذيْن باتا يتحكمان في تصوّرات العولمة الجديدة وفلسفتها وأهدافها، في زمن تحول الرأسمالية إلى نظام متطرّف ومتوحش، غير عابئ بالأخلاقيات التي ينبغي الالتزام بها، في العلاقات الدولية، خصوصا في شقيها، الاقتصادي والاجتماعي.
وبإمعان النظر في النتائج الاجتماعية والنفسية التي أفرزتها السنوات الأخيرة، سيما منذ استئثار الولايات المتحدة بقيادة العالم، نجد أن حالة من الاستياء عمّت ملايين العمال والفقراء، وحتى
النخب السياسية والثقافية، والطبقة المتوسطة وفصيلة من رجال الأعمال في أكثر من بلد، اخترقها الإحساس بالقلق والخوف، بسبب صعوبة التكهن بما ينطوي عليه المستقبل من مآلات ومضاعفات. وخلافا للشعارات التي ترفعها التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تروج قيم السعادة والتضامن والتسامح والرفاهية وحرية المبادرة، فإن الواقع في أجزاء من العالم يفند كل هذه الشعارات، ويفضح تهافت الأدلة والتباسها، وهي التي تتذرع بها هذه التكتلات، لخدمة مصالحها على حساب مجتمعاتٍ تجابه آفات الفقر والمجاعة والأمية. وأخرى أنهكتها الحروب العرقية والأهلية، بسبب انتهاء الثورات المغدورة إلى مسلسلاتٍ طويلةٍ من المآسي والآلام، وبسبب الانسداد السياسي، وانهيار الاقتصاديات والمؤسسات الوطنية، وإفلاس الاختيارات الاجتماعية والتربوية.
والأنكى أنه عندما تفقد الدولة الوطنية زمام الأمور، ويفرض عليها فرضا أن ترضخ لمشيئة القوى الاقتصادية الكبرى وقدرها، وقتئد يفتح باب الانزلاقات على مصراعيه، وقد يتحوّل الاستقرار النسبي الذي ينعم به المجتمع إلى فتنةٍ واضطراب وتوترات. ويرجع هذا الوضع إلى أن صانعي القرار الاقتصادي العالمي ومهندسيه غلبوا ورجحوا كفة المصالح الذاتية على أسباب التماسك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في البلدان النامية، والصاعدة اقتصاديا وسياسيا، وحتى لو أن الأمور قد لا تصل إلى هذا المستوى من الدرامية، فإن الضغوط المتتالية والمتعدّدة التي يمارسها أولئك الأقوياء قد تؤدي إلى نوعٍ من الارتباك في علاقة الدول بمجتمعاتها، وقد يترجم هذا الارتباك إلى مواجهاتٍ واحتجاجات.
تأسيسا على ذلك، يمكن القول إنه إذا لم تتفاعل الدول النامية والصاعدة، بذكاء ويقظة، مع الجيل الجديد من العولمة، بما يعنيه ذلك من استيعابٍ دقيق، وإلمام مكين بأبعادها الظاهرة والخفية، وبمجمل انعكاساتها. وإذا لم تتم مواجهتها بثقةٍ في النفس، ورباطة جأش، بهدف التحكم في تداعياتها وسلبياتها، والاستفادة من إيجابياتها، فإن هذه العولمة قد تنقلب إلى كارثة سوسيو - اقتصادية ستفكك القيم، وستقضي على رهانات التنمية الحقيقية، وفرص الديمقراطية الفعلية والعدالة الاجتماعية المنشودة.